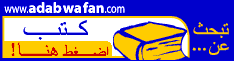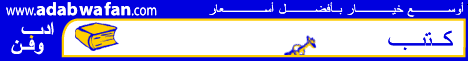|
|
|
|
|
|
"النهار" الثلثاء 17 أيلول 2002 |
|
الايديولوجيا الاقتصادية اللبنانية ومجتمعات الآطراف انحلال تسوية ما بعد الحرب عبد الحليم فضل الله
يعتمد مجتمع الاحتكارات في لبنان، تحالفات غير مستقرة حاليا، بينما يستمد حيوياته ومشروعياته من الخزين الاجتماعي، الطائفي والمناطقي والطبقي، لكن ذلك لا يعني انه لن ينقلب على مصالحه في لحظة ما، اي عندما يصبح التباين مثقلا بتفاوتات حادة، وتغدو التسويات الموقتة مستحيلة بين كتل اجتماعية يزداد تباعدها يوما بعد يوم. على هذا النحو، تكرر الايديولوجيا الاقتصادية المتفرعة عن هذا المجتمع نجاحاتها المفارقة، وينجو معها من محاولات اصلاحية تعكر انسيابه المتواصل. وما زالت المبادئ نفسها التي مهدت له قبل اكثر من نصف قرن، تطبع بقوة الهندسة الاقتصادية الراهنة، وتعيد انتاج الوقائع، بما يتيح لها الصدارة في سباقات الاجتماع اللبناني الكثيرة. القوى التقليدية التي قبضت على المثال اللبناني، وقيّض لها الانفراد بالسيطرة، والاحتكام فقط الى تلويناتها الخاصة، باتت ملزمة اليوم بمد تحالفاتها الى خارج المزيج الاجتماعي الذي تمثله، لعل ذلك يمكّنها من احتواء متغيرات بحجم الحرب الاهلية، والتطورات الاقليمية والدولية الهائلة منذ بداية التسعينات، او يساعدها على تجديد ادوات التحكم والسيطرة المجتمعة في ايديها، ولو على حساب استقلال ذاتي نعمت به طويلا. فلعهد الوفرة شروطه، ولزمن الافقار والتراجع شروط مختلفة، على الاقل لجهة الاستمرار في مراعاة تلك القاعدة الغريبة والاستثنائية: الانفاق التعويضي المتزايد وغير المنتج مقابل الحفاظ على التصميم التقليدي للسياسات، ومقابل تخطي اسئلة استراتيجية جرى استبعادها او القاؤها على عاتق المستقبل، وفي المقدمة سؤالا الحداثة والتنمية، فهذه الاخيرة مطلوبة وملحة حتى في زمن العولمة، المتشددة فعلا، لكن دون ان ترخي ستاراً على جدالات قرن بأكمله؟ مع ذلك، فإن الادبيات اللبنانية، التي عالجت مع نهاية الحرب قضايا الاعمار والبناء والنهوض، أنشأت حقل التفكير بالمستقبل في المكان نفسه، لم تنتظر ما سيسفر عنه الحراك الاجتماعي المستأنف بعد عقدين من الشلل داخل الحرب، بل لعلها سارعت الى استباق نتائجه، او - بقدر من سوء النية - سارعت الى اجهاضه، لو اعتبرنا بعض احداث العام ،1992 استدراجاً للطبقات الصاعدة الى احضان ورثة من ينتفضون عليهم. آلت الاحداث مجدداً الى انتاج الصيغة الاقتصادية نفسها التي سادت سابقاً، لكن استناداً الى أساس سياسي مختلف، يراعي التوازنات الطارئة، وقد اقتضى مركباً سلطوياً مختلفاً، عبرت عنه طبقة سياسية لا تزال تمد التحالف الحاكم بعناصره منذ عشر سنوات. لقد كان تحالفاً مغلقاً ومستقراً الى حد بعيد، وقادراً على تعقيم المؤثرات الخارجية مهما كانت كبيرة، ولو كانت مثلاً بحجم الازمة الاجتماعية، او الاحداث المرتبطة بالصراع مع العدو، او التطورات السياسية التي اعقبت الاستحقاق الرئاسي عام .1998 لكن تلك الطبقة أخطأت مرتين: مرة عندما اعتبرت ان اعادة اعمار منحازة وغير متوازنة ستشق طريقها بسهولة، ما دام المتضررون الفعليون ممثلين بشكل أو بآخر داخل المركب الجديد الحاكم، ومرة ثانية عندما تناست ان تطرّف بعض السياسات المتبعة منذ زمن، أدى الى تكتيل العوامل الاجتماعية المسببة للحرب. وسوغ لها ذلك مجدداً القفز عن أهمية دمج الفكر الاجتماعي في الايديولوجيا الاقتصادية اللبنانية، ولو أنّ مثل هذا التجاوز، يختلف في دلالاته ونتائجه في نهاية القرن العشرين، عنه في الربع الثالث منه، الذي شهد فقاعة الازدهار المعروفة. ومن هذه الدلالات والنتائج، ان ثمن الاصرار على رؤى اقتصادية لا تعمد الى المراجعة او التعديل، رفع رتبة الازمة من مجرد ازمة تنمية يمكن تداركها كما كانت قبل الحرب، الى ازمة اقتصادية ذات أبعاد مالية ونقدية حادة خارجة عن السيطرة كما هي اليوم. في ظل تلك التسوية، التي قايضت تجاهل تنمية الاطراف بضخ متواصل للتعويض الريعي، وبانفاق عقيم، اضطرت الدولة الى دفع فاتورتين متزامنتين، فاتورة اعمار ما هدمته الحرب، واستعادة اقتصاد الاولويات المعروفة، اولوية الحرية المغرقة والقطاع الخاص والنمو على حساب اولوية التنمية والحاجات العامة والتوازن المالي،... وفي جانب آخر فاتورة الاعباء الجانبية لخيار المضي قدماً في بناء اقتصاد احادي، في وقت بات فيه لمجتمعات الاطراف المهمشة، نفوذ لا يمكن إهماله، لأسباب سياسية معقدة.
تحديات جديدة لن يمثل مجتمع الاحتكارات في لبنان أمام ظروف هادئة ومواتية كالتي خبرها منذ الخمسيات وحتى عشية الحرب، بل هو مرغم على مواجهة عاصفة من التغيرات، قد تقنعه في النهاية بأنه لجأ الى تبسيطات مجحفة عندما اعتقد بملاءمة نموذجه التقليدي للتيارات العالمية الجديدة، وأنه في ذلك اسقط من حسبانه أهم التحولات الداخلية والخارجية. في السابق استفاد هذا المجتمع، من طول فترة الازدهار لاثبات صحة خياراته، رغم ما احتواه هذا الازدهار من تمييز قاسٍ، لكن طي صفحة النمو يجعله أمام امتحان اثبات الجدارة والاهلية في تسيير الشأن الاقتصادي وقيادته، ولن يفوز به ما لم يسجل نجاحات لا يبدو مهيأ لها. لقد مارست الشريحة المسيطرة ليبراليتها سابقاً خارج أي نظام للعقوبات، ومن دون شروط، فيما ستخضع اليوم بقوة لرقابة عوامل انتجتها التطورات، في مقابل الصلاحيات الواسعة التي تمتعت بها في السابق وانتجت بعض مكاسبها وانجازاتها. هناك أولاً رقابة النظام السياسي وقد بات كما أسلفنا، متنوع التمثيل ومتعدد مصدر السلطة، ولا يمكن ربطه بحيثية اجتماعية واقتصادية واحدة. قبل الحرب، ساهم التشابك، بل التطابق أحياناً، بين مركزي القرار الاقتصادي والسياسي، في منح النموذج اللبناني أسباب التماسك والاستمرار، كما انعكس تجانساً مقبولاً في المجتمع السياسي منحه قدرة على التفرد، وشيئاً من التواطؤ الضمني على غض النظر عن الآثار الاجتماعية لاحاديته. الانفصال المستجد بين مركزي القرار هذين، أدى الى صعوبات محددة، وأوجد آلية دائمة لانتاج الازمات، ولأول مرة تصبح الرأسمالية اللبنانية خاضعة بشكل ما للسياسة، وهذه الاخيرة متقلبة وغير مستقرة لاعتبارات محلية وغير محلية. ... هناك ثانياً رقابة الازمة الاقتصادية، فقد بنى النظام الاقتصادي الاجتماعي نجاحاته الآنفة، بالمراهنة على ثبات الفرضيات، وقد تعامل بالفعل لأكثر من اربعة عقود مع ظروف مستقرة إجمالاً، لم يعرف المجتمع اللبناني في السابق الازمات الشاملة، فأمكن له بسهولة مواصلة السياسات الاقتصادية نفسها دون مراجعة او تخطيط، وقد اعتبر انها الامثل فقط لأنها قادرة على الاستمرار دون التسبب بانهيارات مالية ونقدية، في معزل عن نوع التدهور الاجتماعي الناجم عنها. الليبرالية اللبنانية المتشددة، ملزمة اليوم بالازمة ونتائجها قبل استئناف خطتها السالفة، ومقيدة باتباع تحليل اقتصادي لم تعتده، يفرض ممرات اجبارية، او يقدم في احسن الحالات خيارات قليلة، قد يفسر ذلك فشل التحالف السياسي الحالي في التعامل مع هذه الازمة، وعدم كفايته في اتخاذ قرارات صائبة في شأن مخارجها، يفسر ذلك أيضاً عجزه عن تحريك مقولاته الاقتصادية بعيداً عن الثنائيات التي كانت جائزة فقط في زمن الاستقطاب الايديولوجي، فيما من المتوقع بين فينة وأخرى انبعاث طريق ثالث عالمي، يدعو الى الكثير مما يأنف منه النظام اللبناني، وربما يدفع الى مصالحة مفهوم السوق مع مفهوم العدالة، ومفهوم الحرية مع مفهوم الرقابة، واولوية القطاع الخاص مع التخطيط والبرمجة. هنالك ثالثاً رقابة السوق الدولية إذ ادخلت العولمة الاقتصاد العالمي الى عصر الشكبات المعقدة والمتعددة العنصر، فباتت النماذج السابقة لليبراليات المحلية قاصرة وغير قابلة للحياة. في الحديث عن العولمة، لا بدّ من الاشارة الى التعريف المبسط الذي تستعمله الليبرالية اللبنانية الوافدة، لتبرير انقضاضها المتسرع على دور الدولة، فتتجاهل ان حقل التفكير حول العولمة يتسع باستمرار، فالمراجعات الجديدة لفكر العولمة تصل عند البعض الى حد ربط نمو القوى الاقتصادية العالمية (الشركات المتعددة مثلاً)، بالتكوينات التي اعتقد سابقاً انها مضادة لها، كالدولة، فيما اثبتت التجارب الناجحة في الربع الاخير من القرن العشرين، ان تنامي المخاطر المترتبة على الانفتاح الدولي يؤكد دور الدولة بدلاً من تهميشه، باعتبارها الضمانة الوحيدة لبيئة اعمال مأمونة، والطرف المستعد دائماً لدفع "فاتورة التأمين ضد المخاطر". ان تنامي قوة التكتلات ما فوق - الوطنية وما دون - الوطنية، يشدد مجدداً على أهمية مهمة الدولة في القيام بدور المنظم والموازن ما بين اطراف متناقضة غالباً، ويؤكد أيضاً على ضرورة حضورها كجهة ملزمة باستيعاب النتائج التي تعاني منها الفئات الخاسرة في معادلة العولمة، والادنى طاقة على تحمل تبعاتها. الفهم المختزل والمبسط لحقائق العولمة هو الذي يقود حالياً فكر الدولة في لبنان، ويبني مذهبها الخاص ويرسم تعريفها لنفسها، وتقديراتها للمستقبل، وتعتبر قوى النظام، المسؤولة عن ترميم الايديولوجيا الاقتصادية اللبنانية وتنشيطها. أنّ مشروعية رؤيتها مستمدة من انضمامها المزعوم الى ما يسمى بالاقتصاد الجديد، رغم انها تنضم فعلاً الى أحد تياراته الاكثر تطرفاً، والادهى انها تضع هذه الشرعية، في مكان شرعية الاختيارات الجماعية التي توفرها الديموقراطية. في الخلاصة ان الصعوبات الجمة التي يعانيها لبنان، أثناء اعادة بنائه لمسرحه الاقتصادي هي من نتائج مفارقات باهظة الكلفة، من أهمها: أولاً: الادراك القاصر لتطورات العقدين الاخيرين وسوء فهم متغيراته الاقليمية والدولية، النظرية والتطبيقية; ثانياً: حصر آلية اتخاذ القرار الاقتصادي في ناد اقلوي غير متنوع، مع الفصل بين آليتي القرار الاقتصادي والسياسي; ثالثاً: الالتزام بشراكة مجتمعات الاطراف، لكنها شراكة لم تكن مؤثرة على المسار العام، بقدر ما كانت مرتفعة الثمن. ولسوف نجد أن الجفاف المالي الناجم عن الازمة، ادى الى نتيجة رئيسية، هي انحلال التسوية التي اعقبت الحرب، وهدفت الى ادماج مجتمعات الاطراف هذه في الايديولوجيا اللبنانية، عبر الانفاق الريعي العابر، لا عبر التنمية المقيمة.
نائب رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق |
الصفحة الأولى| محليات سياسية|اقتصاد-مال-أعمال|العرب والعالم| قضايا النهار|القضاء والقدر|مقالات|المقسم 19|وراء الحدث| مذاهب وأديان | تحقيق| مناطق| بيئة وتراث| مفكرة|أدب-فكر-فن|مدنيات-تربويات|وفيات| رياضة| حول العلم والعالم|مرايا الأحوال| نهار الشباب| كومبيوتر وانترنت | النهار الرياضي |مساعدة|
الدليل| الملحق الثقافي| سلامتك| الاغتراب اللبناني| الصفحة الرئيسية