 |
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة السكن
د. دريد درغام *
فهرس المحتويات
اقتصاد الظل ودوره في التأثير على مصداقية المعلومات وتشتيت التخطيط الاقتصادي.
التباين بين السكن المخطط والمنفذ
السياسة السكنية وآفاق المستقبل
دور السياسات الضريبية والمصرفية
مقدمة
تتميز خطط التنمية بوجود تكامل في الرؤية الاقتصادية في معالجة المشاكل. نحاول في هذه المحاضرة تسليط الضوء على السياسات السكنية وأهميتها في دفع عملية التنمية.
يوجد حسب تعداد المساكن لعام 1994 في سوريا 2 457 902 مسكناً جاهزاً للسكن، منها 54% في مناطق الحضر. أما عدد المساكن المعتادة [2] فقد بلغ 2 578 564 مسكناً منها 4.68% غير جاهزة (على الهيكل).
ويمكن مقاربة حالة السكن في سوريا باستخدام معايير أخرى مثل:
معيار حصة الفرد من الأمتار المربعة: حسب أرقام المجموعة الإحصائية، ارتفعت حصة الفرد من الأمتار المربعة السكنية من حوالي 11 م2 في بداية السبعينات إلى 14 في نهايتها لتصل إلى جوار 16 في وسط الثمانينيات ثم تناقصت من جديد إلى جوار 14م2 للفرد الواحد.
معيار التزاحم (عدد الأفراد في الغرفة): تناقص تزاحم الأفراد من 2.6 فرد/غرفة في 1970 إلى 2 في التسعينات.
معيار الإشغال: يظهر الجدول 1 إحصاءات السنوات 1970 و1981 و1994
الجدول 1
|
1994 |
1981 |
1970 |
نسبة إشغال المساكن الجاهزة للسكن |
|
82% |
82% |
95% |
الحضر |
|
85% |
87% |
90% |
الريف |
|
84% |
85% |
92% |
سوريا |
المصدر ملف الإثنين جريدة البعث 21/6/1999 صفحة 7
معيار المرافق العامة: يبين الجدول 2 تطور النسب المئوية للمساكن التي تستفيد من المرافق العامة حسب الإحصاءات الدورية التي تمت في أعوام 1970 و1981 و1994 في سوريا:
الجدول 2| 1994 | 1981 | 1970 | ||
| 99% | 96% | 85% | حضر | إنارة |
| 92% | 57% | 10% | ريف | |
| 92% | 87% | 83% | حضر | شرب |
| 55% | 35% | 11% | ريف | |
| 92% | 92% | 81% | حضر | صرف صحي |
| 28% | 15% | 5% | ريف |
المصدر: ملف الإثنين جريدة البعث 21/6/1999 صفحة 7
نلاحظ التقدم الكبير في خدمات السكن خلال العقود الماضية.
أتكفي هذه المعايير الإجمالية لتقييم حالة السكن في سوريا؟ وماذا عن الارتيابات في الأرقام الإجمالية (مساكن غير مشغولة، سكن مؤقت…)؟
تتعلق هذه الأرقام بتعداد السكان الإجمالي وتهمل عدد الشرائح القادرة أو المؤهلة فعلياً على السكن المستقل (سواءً من حيث العمر أو الإمكانيات). وهناك أهمية لنسب هذه التقديرات إلى تلك الشرائح أسوةً بما نفعله في دراسة البطالة عند نسب أعداد العاطلين عن العمل إلى القادرين عليه وليس إلى عدد السكان الإجمالي. وهناك أهمية لاعتبار التباين (التشتت) الشديد بين عدد العائلات (عدد الأولاد في كل عائلة)… وقد تُكوِّن معايير تزايد التزاحم في المدن الجامعية وتزايد السكن العشوائي بعض المؤشرات التي تؤكد عدم دقة الأرقام وضرورة التروي في الاستنتاجات.
من خلال الشكل 1 الذي يقارن تزايد المساحة السكنية الكلية مع عدد السكان في سوريا، نلاحظ أن معدل تزايد الاستثمارات السكنية في فترة السبعينات أكبر بكثير من معدل تزايد السكان. إلا أن هذه الظاهرة قد انخفضت بكل ملحوظ في الثمانينات وأصبح معدل تزايد السكان أكبر في التسعينات.
الشكل 1 
في البداية، نحاول انطلاقاً من واقع الإحصاءات الرسمية، تقدير الفجوة السكنية بين أرقام الوحدات السكنية المتاحة وحجم الطلب التقديري على السكن.
الفجوة السكنية
بلغ عدد السكان في سوريا ممن تجاوزوا العشرين عاماً 5.3 مليون نسمة عام 1992. ووصل عدد الوحدات السكنية (المشغولة والخالية) في تلك الفترة إلى 2 مليون وحدة. وباعتبار نسبة الانشغالية العامة والتباين الحاد بين مناطق الريف والحضر، نستطيع افتراض أن ثلث الشريحة السكانية المذكورة أعلاه من ذوي السكن المستقل (سواءً تملكاً أو استئجاراً). وهذا يعني أنه يقطن مع كل شخص يستقل بوحدة سكنية شخصان آخران إضافةً للأولاد دون العشرين من عمرهم. [3]
فإذا حسبنا متوسط التزايد السنوي لشريحة السكان ممن يجاوز عمرهم 20 عاماً خلال عقد التسعينات لوجدنا أنه يقارب 200 ألف نسمة. وضمن الفرضيات المذكورة أعلاه (أي ثلث هذه الشريحة يقطن منزلاً سواء بالتملك أو الاستئجار)، نجد خلال تلك الفترة أن عدد الوحدات السكنية الجديدة المطلوبة 65 ألف وحدة. وبالعودة إلى وسطي الوحدات السكنية الجديدة (في القطاع الخاص والتعاوني) خلال التسعينات، نجد أنه يقارب 35 ألف وحدة (وانخفض في 1998 إلى حوالي 20 ألف وحدة). أما وسطي الوحدات السكنية الجديدة في القطاع العام فلم تتجاوز 20 ألف وحدة؛ وذلك بفرض أن مساحة الشقة السكنية فيه حوالي 80 م2 (انظر الشكل2).
الشكل 2: المساحة السكنية الجديدة في سوريا بآلاف الأمتار المربعة [4] المصدر: المجموعة الإحصائية، جداول البناء والتشييدملاحظة: لم نستطع استكمال سلسلة إنفاق القطاع العام على البناء نظراً لتغيير محتوى جدول المساحات السكنية الكلية (15/6) الذي كنا نعتمد عليه في استخلاص حصة القطاع العام، وذلك اعتباراً من عام 1994 .
التحليل السابق يدل على أن الطلب على السكن أكبر بكثير من العرض التقديري، مما يستدعي زيادة في الأسعار؟ إلا أن الواقع دل على عكس ذلك، فقد شهدت سنوات التسعينيات السابقة انخفاضاً للأسعار ثم ركوداً عاماً في سوق العقارات؟ فلماذا؟
للإجابة على ذلك، نثير النقاط الآتية عسى أن تلقي الضوء على الجزء الأكبر من التفسير الممكن لتقلبات أسعار السكن:
· انخفاض القوة الشرائية لدى أصحاب الدخل المحدود (وهم الأكثرية): رغم الزيادة الأخيرة في الدخل، إلا أن القوة الشرائية للموظف العادي ما زالت ضعيفة ولا تسمح له بتسديد الأقساط المطلوبة للسكن. فمن أجل قرض 500 ألف لمدة 20 عاماً يسدد بأقساط ثابتة بفائدة 4% فقط يجب على المقترض أن يدفع 3000 ل س وهو قسط يتجاوز نصف الراتب الوسطي! نظراً لانخفاض القوة الشرائية ولعدم توفر الادخار الكافي لدى أصحاب الدخل المحدود لا بد وأن ينخفض الطلب على السكن بشكل كبير.
· انخفاض فرص العمل الجديدة وبالتالي نقص الطلب الفعلي: كنا قد قدرنا في محاضرتنا حول البطالة في ندوة سيما الاقتصادية الأولى أنه بفرض عدم وجود بطالة حالياً في سوريا، وتحت الضغوط الديمغرافية فيها، فإننا بحاجة إلى 200 ألف فرصة عمل سنوياً خلال العشر سنوات القادمة لمواجهة أعداد القادمين إلى سوق العمل. [5] وأظهرنا، في حال استمرار السياسات الاقتصادية السابقة، صعوبة تحقيق هذا الهدف. ونوهنا إلى مختلف العوامل التي تهدد بزيادة حجم الوافدين إلى سوق العمل (استبدال العمال بالتقانة الحديثة، البطالة المقنعة وخطط إعادة الهيكلة في جميع القطاعات، العمالة السورية الكامنة في لبنان، محاربة التهريب والممارسات الربحية غير الشرعية..). وقد أظهرنا أن عدد فرص العمل الجديدة في سوريا في فترة التسعينات لم تتجاوز 50 ألف فرصة في أحسن الأحوال (بما فيها القطاع العام والخاص بجميع قطاعاته). [6] وهذا ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى المعيشة وبالتالي انخفاض الطلب الفعلي على السكن. وتزايد عدد طالبي السكن الكامنين المضطرين للسكن عند أهاليهم! وهذا ما دفع الأسعار في الاتجاه المعاكس أي انخفاض الأسعار.
· عدم وجود قانون فعال ينظم عملية الاستئجار: تسبب غياب قانون واضح ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى خوف الكثير من المالكين من تأجير منازلهم. وأدى ذلك إلى تخفيض عدد الشقق المتاحة للإيجار مما زاد في قيم الإيجارات في المدن الكبيرة التي تعاني من هجرة مكثفة من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى تزايد عدد الباحثين عن عمل فيها. وكلنا يعلم السلبيات التي نتجت عن قانون الإيجار السياحي. والآن بعد صدور قانون الإيجار الجديد عام 2001 ما زال العديد من المختصين والمعنيين بمشاكل السكن ينبهون إلى سلبيات وثغرات إضافية لم يغطيها أو تسبب بها هذا القانون.
· السكن العشوائي ودوره في زيادة العرض: ساهم السكن العشوائي غير المنظم، خلال الفترة الممتدة من 1981-1994في تأمين 65% من السكن في دمشق وفي تأمين 50% من السكن على مستوى القطر. ووصلت نسبة سكان المخالفات إلى 36% من سكان دمشق و32% في حلب و40% في حمص. [7] إن ظاهرة السكن العشوائي (التي تطوق المدن الكبيرة وتشوه المنظر العمراني فيها مما يبرر دعونها بأحزمة الفقر) تعود إلى عدة عقود من الزمن بسبب نزوح السكان عن المناطق المحتلة. إلا أن العقدين الأخيرين قد شهدا نمواً سريعاً جداً لظاهرة السكن العشوائي بسبب: أسعار السكن النظامي المرتفعة بالنسبة لمتوسط الدخول والأجور، وتمركز الأنشطة في المدن الكبيرة. فلم تجد شريحة كبيرة من الشعب أي متنفس لها سوى في الاعتماد على الأراضي الزراعية أو المحمية في بناء مساكن لا تخضع لأي نوع من المعايير الفنية أو الصحية أو البيئية. ونظراً لعدم توفر الخدمات فيها، فقد تسببت هذه المناطق خلال سنوات طويلة بإرباك حقيقي في شبكة المياه والكهرباء وفي تنظيم الخدمات العامة. وتأثرت الخدمات في مناطق السكن النظامية نظراً لتخصيص جزءٍ من الموارد لتخديم مناطق السكن العشوائي التي لا تشارك أساساً في الإيرادات. وتحسن الوضع قليلاً بعد السماح لسكان تلك المناطق بالاشتراك نظامياً في الخدمات الرئيسية (ماء وكهرباء).
· عدم استكمال المشاريع السكنية بالخدمات اللازمة إضافةً إلى أزمة المياه: تعاني الكثير من المشاريع السكنية التي أنجزت أو يمكن إنجازها من غياب أو سوء الخدمات والمواصلات بالإضافة إلى أزمة المياه الحادة التي تدفع بالكثيرين إلى شراء المياه لفترات طويلة. مما يخفض من الطلب على السكن في هذه المناطق، ويخفض من الإيجارات فيها (مثال: حرستا بما فيها ضاحية الأسد).
· غياب الفرص البديلة: ساهمت الفرص البديلة (قانون رقم 10 وجامعي الأموال..) في تشجيع المالكين على بيع العقارات وتوظيف السيولة في استثمارات أكثر ربحيةً. ولكن بعد التراجع الحاد في الفرص البديلة وضبط ظاهرة جامعي الأموال، لم تعد هناك فرص استثمارية تشجع على بيع العقارات (ولا على شرائها). فتضافرت جميع العوامل اللازمة لركود سوق السكن.
اقتصاد الظل ودوره في التأثير على مصداقية المعلومات وتشتيت التخطيط الاقتصادي
لننظر في الشكل 3 الذي يبين تطور وسطي مساحة الوحدة السكنية المنفذة في القطاع الخاص والتعاوني (ريف وحضر). نلاحظ دوماً أن مساحة الوحدة في الأرياف أكبر من الحضر وهذا أمرٌ متوقع. كما نرى أن المساحة الطابقية للوحدة السكنية يتزايد لدى الحضر والريف على حد سواء. [8] فبعد أن كان في جوار 115 للحضر أصبح 120 م2 للوحدة وكان في جوار 125 للريف وأصبح في جوار 130 م2 للوحدة. وقد يكون مرد ذلك إلى رخص تكلفة البناء في الريف وكذلك لأسباب اجتماعية وثقافية (ارتباط البيوت الريفية بمفهوم الاتساع والرحابة والضيافة…).
الشكل3: تطور مساحة الوحدة السكنية في سوريا
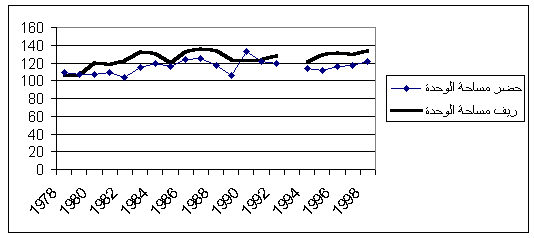
المصدر: المجموعة الإحصائية
إلا أن الإحصاءات الرسمية غالباً ما تشوبها ارتيابات كبيرة لأنها إجمالية من جهة ولكونها تتأثر بحدة بواقع السكن العشوائي. ويقدم لنا قطاع البناء السكني مثالاً على صعوبة تقدير حقيقة الفعالية الاقتصادية. حاولنا مقارنة الإنفاق الإجمالي المُشار إليه في المجموعة الإحصائية مع مؤشرٍ جديدٍ اعتبرنا أنه يعكس حقيقة الإنفاق على البناء بشكل أفضل. سنهتم فقط بتقدير الإنفاق على البناء السكني الجاهز فقط. كما نعلم لا تُسجل الأبنية غير النظامية في الدوائر العقارية مما يعني إغفال المبالغ التي أنفقت عليها. ولكن بالمقابل، سُمِح لأصحاب هذه الدور السكنية بتركيب عدادات كهرباء. سنقوم ببعض الفرضيات المبسّطة. بفرض أنّ كل المنازل الجديدة قد ركبت عداداً وأنّ كلّ عدادٍ جديدٍ يُقابل شقةً جديدةً. وبالاعتماد على الشكل 3 والتحليل الذي رافقه حول الأبنية السكنية الجديدة للقطاعين الخاص والتعاوني، نستطيع أن نفرض أن مساحة الشقة السكنية لا تقل عن 100 متر مربع، ومع ذلك فسنفترض بغية عدم المبالغة أن المساحة 80 م2. لو أخذنا سعر المتر المربع الوسطي للسكن الجيد والعادي (والمنفذ من القطاع العام) كما ورد في المجموعة الإحصائية لأعوام التسعينات (ودورناه إلى الألف الأدنى رغبةً منا في عدم المبالغة)، فإننا نجد أنه يساوي 5000 ل س. وهكذا تكون تكلفة الشقة الوسطية 400 000 ل س. حسب إحصائيات وزارة الكهرباء يصل التزايد السنوي لعدادات الكهرباء المنزلية إلى 90 000 عداداً (وسطي للفترة 1980-1995). [9] باعتماد هذه الأرقام نجد أن الإنفاق على البناء السكني لعام 1995 يساوي 36 مليار ليرة. وهو رقم يتجاوز بكثير مبلغ الإنفاق الكلي على فعالية البناء والتشييد كما ورد في الإحصائيات الرسمية. وحسب المجموعة الإحصائية، وصل الإنفاق في عام 1995 إلى حوالي 30 مليار وتُعتبر الأعلى في عقد التسعينات، إذ يلاحظ انخفاض قيمة الاستثمار في مجال السكن ليصل إلى حوالي 22.8 مليار عام 1999. وهذا أمرٌ طبيعي بسبب انتهاء فقاعة المضاربة السكنية (انظر الشكل 2). إنّ الارتياب الكبير في تقدير هذه الأرقام يؤثر كثيراً على السياسة الاقتصادية. فهي تؤثر على:
· خطة الدولة في ضبط أسعار و توزيع مواد البناء (الحديد و الإسمنت...) في السوق المحلية و خطة التصدير إلى الخارج.
· مستوى استثمار التجار و الصناع في القطاعات المشتقة (أو التابعة لقطاع البناء) مثل المفروشات والمواد و الخدمات المنزلية (أي فعالية دراسات السوق).
· تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال البناء لعدم توفر المعطيات الدقيقة حول حاجة السوق الحقيقية.
إن المثال الذي ذكرناه بخصوص إعادة تقييم الإنفاق السكني هو أحد الأمثلة التي يمكن اللجوء إليها للوصول إلى جزء من الحقيقة صعبة المنال نسبياً في البلدان النامية. وتوجد إجراءات إعادة التقييم في البلدان المتقدمة أيضاً. فنظراً لانتشار فعاليات اقتصاد الظل في إيطاليا مثلاً يقوم المسؤولون هناك بإعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي (بلغت نسبة إعادة التقييم 10% في عام 1977 و بلغت 16% في عام 1987). [10]
وننتقل الآن إلى دراسة الفارق التراكمي الكبير بين حجم السكن المرخص والسكن المنفذ على مستوى القطر.
التباين بين السكن المخطط والمنفذ
عندما تقوم السلطات المعنية بترخيص الوحدات السكنية، فمن الطبيعي ألا يتم التنفيذ المرخص في إحدى السنوات بكامله خلالها وإنما يتم استدراكه أو تحقيقه تدريجياً خلال السنوات التي تليها… وهكذا نتوقع، خلال سنوات النشاط الاقتصادي، وجود فرق كبير بين المساحات المرخصة (مضافاً إليها التراخيص المتراكمة من السنوات السابقة والتي لم تُنفَّذ) مقارنة بالمساحات المنفذة. وفي فترات الركود، تتباطأ حركة ترخيص المباني ويتزايد حجم المساحات المنفذة مقارنة بما هو مرخص.
عندما درسنا الأرقام الواردة في الإحصاءات الرسمية وجدنا عدم وجود علاقة مع الحالة الاقتصادية لما هو مرخص وما هو منفذ. ويبدو بوضوح من خلال الشكل 4 أن التباين الواضح يرتبط بكون الاستثمار السكني في مناطق الريف أم في الحضر. وقد أنشأنا هذا الشكل بعد طرح المساحات المرخصة من المنفذة. وفي كل عام كنا نضيف الفرق إلى المتراكم من السنوات السابقة. فظهر لدينا تنافر واضح في السلوك بين مناطق الريف ومناطق الحضر.
نلاحظ أن المساحات المنفذة في مناطق الحضر أكبر بكثير من المساحات المرخصة والفرق التراكمي (الزيادات المنفذة التي لم تُرخَّص على الأقل في الجداول الرسمية) مستمر منذ نهاية السبعينيات. وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن حقيقة أرقام سكن الحضر التي تم تحليلها، وعن إمكانية وجود تجاوزات بحيث يقوم البعض بتنفيذ مساحات إضافية كبيرة مقارنة بما هو مرخص (على أمل المصالحة عليه لاحقاً). ويؤكد د. ربداوي على أن العديد من المساكن تٌبنى دون ترخيص. [11] وسواءً تم تنفيذ هذه المساكن في مناطق معدة للبناء أم في المساحات الزراعية والمحمية، فإن في ذلك دليل واضح على صعوبة التخطيط العمراني.
بالمقابل، يُلاحظ تناقص المساحات المنفذة بالريف مقارنةً بالمرخصة منذ بداية الثمانينيات. وقد يعود السبب في ذلك إلى ظواهر الهجرة من الريف إلى المدينة وضعف المستوى المعيشي في هذه المناطق…
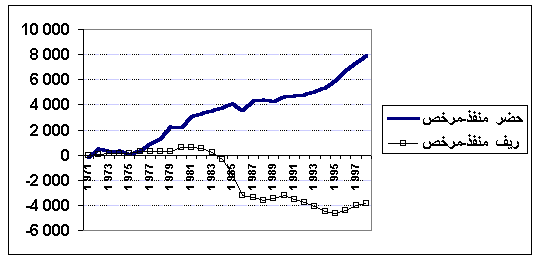 |
الشكل 4: تراكم المساحات المنفذة وغير المُرخصة
المصدر: المجموعة الإحصائية
يتسبب التباين الحاد المشار إليه أعلاه بإرباكات خطيرة على مستوى التخطيط الاقتصادي نظراً لارتباط العديد من القطاعات بمشاكل السكن وأهمية معرفة الحجم الحقيقي لقاطني كل منطقة. فمن خلال هذه الإحصائيات يمكن للجهات المعنية تحديد حجم الاستثمارات الخدمية (طرق، مدارس، كهرباء، ماء…). فضلاً عن الرسوم المهدورة المتعلقة بالسكن المنفذ غير المرخص، وعن تأثر المخططات التنظيمية وتحديثها بالشكل الذي يسمح بسياسة تنظيم عمراني تتناسب وطموحات بلدنا.
السياسة السكنية وآفاق المستقبل
نتوقع بأنه سيكون من المفيد عدم قصر الدراسة على تفاصيل الأرقام المتوفرة والتي يشوبها الكثير من الارتيابات للأسباب التي سبق وأوردناها. ونتطلع إلى طرح تساؤلات من طبيعة جديدة تختلف عن العقلية الحالية التي تقول بوجود متطلبات سكنية تحاول تلبيتها حسب الإمكانات المتاحة. إن هذا النوع من التفكير منفعل passive يتأثر بالتغيرات التي تفرضها الظروف؛ وليس فاعلاً بمعنى أنه لا يسمح بتوجيه الاقتصاد والحياة الاجتماعية بما يتوافق والمصالح الاجتماعية العليا.
نعدد من هذه التساؤلات الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر:
E ما هي طبيعة المساكن المستقبلية التي تتناسب ومناخ سوريا وتطلعاتها الاقتصادية؟ وما هي الصورة العمرانية التي ترغب سوريا بالوصول إليها في العقود المقبلة؟
E ما هي طبيعة العلاقة التعاقدية في مجال السكن التي تسعى الحكومة لترسيخها في المستقبل بين المستثمرين في بناء السكن والمواطنين؟ هل ترغب بالتركيز على سياسات الإيجار أم سياسات التملك؟ وما هي تبعات الإجراءات التي ستنفذها الحكومة؟
من خلال الدراسة المعمقة لهذا النوع من التساؤلات، تُحدَّد الكثير من العوامل اللازمة لتفاعل مختلف السياسات؛ ونحصل على التناغم المطلوب في خطة الحكومة على الأمد البعيد، بحيث يتم ضبط الخطة بشكل دوري تبعاً للمستجدات والانحرافات عن الأهداف المعلنة.
وما نقصده بالتناغم هو ألا يقتصر التشاور بين الجهات المعنية بصناعة القرار على الإجرائيات والتقارير التي أفرغها الروتين من فاعليتها؛ فقد مضى على قرار تحضير مخطط دمشق أكثر من 12 عاماً دون نتيجة ملموسة. وهنا نتساءل عن جدوى الاستمرار به بناءً على المعطيات التي مضى عليها سنوات طويلة في ظل بيئة عمرانية شديدة التغير. وما زال مخطط دمشق "بعد كل المراحل التي تم الحديث عنها متعثراً، وفشلت كل الجهود السابقة في استكماله، وما زالت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية تتخبط في كل الاتجاهات دون أن تُعطي شيئاً سوى الكلام والسبب كما يقول بعض المختصين أن القائمين على إنجاز المخطط هم مهندسون غير مؤهلين تخطيطياً". [12]
وهنا نتساءل هل السبب في عدم إسناد المهمة إلى الكفاءات المؤهلة؟ أم أن البعض يستفيد من التأخير ويتعمد إطالة أمد المشروع أو تجديد طرحه دون تنفيذ فعلي!
لا يمكن لأحد أن يحقق منافع فردية على حساب الصالح العام إلا في ظل بيئة ضبابية تغيب فيها الضوابط العامة. وهناك إشكالية حقيقية في تنفيذ رقابة صحيحة في ظل بيئة لا تأخذ بالاعتبار ديناميكية الحركة وتغير الظروف. وتؤدي الضبابية وسوء تفسير القواعد الناظمة (أو جمودها) إلى تحريض التجاوزات، لا بل قد تصبح التجاوزات هي القاعدة. وهنا يأتي دور الأفراد القائمين على الرقابة إما في تفسير القوانين وفق الصالح العام أو في استغلال الظروف وتحقيق مكاسب فردية ونشر الفساد الإداري. [13]
نأمل أن ترسم كل جهة أهدافها البعيدة الأمد وأن يتم التنسيق بينها من خلال رؤية شمولية ترسم المهام الوطنية وتحولها إلى برامج ومشاريع ذات أهداف محددة، وتأخذ بالاعتبار الموارد المتاحة. يسود حالياً العرف القائل بتخطيط المستقبل ووضع الموازنات بناءً على معطيات الماضي (بزيادة نسبة مئوية). رغم أهمية اعتبار الماضي، نحن نعتقد بأن المعطيات المعتمدة حالياً تعاني من ارتيابات كبيرة، كما أصبح التخطيط بناءً على التطلعات المستقبلية ضرورةً ملحة في عصر العولمة الحالية.
المطلوب تساؤلات مختلفة جذرياً
تحيط بنا تحديات قادمة كثيرة نذكر منها المياه، والطاقة، والنقل، والضغط السكاني، السكن العشوائي… وهناك ارتباط حيوي بين السلبيات التي يعاني منها أي قطاع وما يرتبه من سلبيات إضافية على القطاعات الأخرى. لن نذكر من الأمثلة إلا ما يتعلق بقطاع السكن. يؤدي استقطاب العمالة (غير المخطط) إلى المدن الكبيرة الداخلية (غير المؤهلة لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة) إلى نمو الاقتصاد غير المنظم وإلى العديد من المظاهر السلبية مثل:
E ازدحام كبير في الطرقات.
E تلوث تساهم به بشكل كبير أعداد السيارات القديمة.
E عدم احترام أنظمة المرور بسبب غياب مرتكزات المدن الكبيرة من مرائب وطرق عريضة...
E تتمركز المدن الكبيرة في الداخل السوري، وتتميز المدن الداخلية ببرودتها العالية شتاءً وحرها الشديد صيفاً مما يزيد بكثرة من استهلاك مصادر الطاقة.
E يؤدي ضعف القوة الشرائية وغلاء السكن النظامي إلى تزايد السكن العشوائي وسوء الأحوال الصحية التي يحياها قاطنو تلك المناطق. وهذا يؤثر على الشكل الجمالي للمدن ويزيد من نفقات العلاج الصحي. وما قد يساهم في زيادة الخطر هو تنفيذ بعض أحياء السكن العشوائي في مناطق غير مدروسة (غير مستقرة) جيولوجياً مما يهدد أرواح قاطنيها مستقبلاً. كما يؤثر السكن غير المنظم على تخطيط بقية الخدمات مثل المدارس والحدائق والأنشطة المختلفة الضرورية للأطفال.
E تتأثر مختلف شبكات النقل بما ذكر أعلاه. وتؤدي العوامل السابقة إلى تقليص حجم شبكة المواصلات في بعض المناطق مما يُصعِّب عملية صهر الثقافات وبناء وطن موحد. وقد ذكر المؤرخ الفرنسي فرناند برودل أن الفضل يعود للسكك الحديدية في جعل فرنسا أمة موحدة وثقافة موحدة. [14] ونعتقد بأن الخضوع المتزايد لظاهرة التجمعات السكنية في مدن محددة لا بد وأن يخفض كثيراً من انتشار شبكات النقل ويُخفض من إمكانيات التواصل بين المناطق النائية "المتزايدة" عدداً ومناطق الحضر "المتفاقمة" حجماً. وهذا الأمر يهدد بخلق مجموعة من الجزر المعزولة (غيتو Ghetto) وما يتبع ذلك من صعوبة صهر الجماعات المتباينة في ثقافة يفترض أن يؤدي تنوعها إلى مزيد من الغنى الثقافي ولكن يفترض فيها أيضاً أن تكون متناغمة.
E تشوه الملامح العمرانية للمدن: يمكن تقسيم المدن الكبيرة مثل دمشق عمرانياً إلى ثلاثة أو أربعة أنواع: العمران القديم المتمركز في الأحياء القديمة تاريخياً، العمران الحديث التقليدي (الأبنية الإسمنتية التقليدية) والفيلات ذات الطراز الأوروبي، ومناطق السكن العشوائي. ويلاحظ عدم الانسجام بين العمارة الشاقولية في الأبراج السكنية من جهة والانتشار الأفقي وما يُسببه من تآكل في الأراضي الزراعية. مما يخلق تنوعاً معمارياً هجيناً يتجاور فيه الرخام مع الحديد مع الصفيح مع الإسمنت مع الخشب مع الطين… ويؤثر ذلك على مختلف الأنشطة الوطنية وبالأخص السياحة.
نعتقد بضرورة استشراف المستقبل وتبني سياسات تخطيط لآفاقٍ بعيدة الأمد. تحاول هذه السياسات رسم وجه سوريا العمراني والسكني في المستقبل. وهنا نقترح أن يكون الحل الحقيقي في السياسات الوقائية أو الاحترازية أكثر منه في معالجة نتائج أخطاء سياسات التخطيط السكني والعمراني والاقتصادي عموماً في الماضي. ولا نعتقد بصحة الآراء القائلة بأن مشكلة السكن تكمن في المساكن الخالية غير المشغولة. فقد بلغ عدد المساكن الخالية الصالحة للسكن في دمشق 53 063 مسكناً فقط في تعداد عام 1994؛ فهل توفر إتاحة هذا الرقم حلاً فعلياً لأزمة السكن في دمشق؟ لا بد من اعتماد حلول جذرية. ويقول البعض بأنه قد يكون في مدينة الثورة السكنية "مثالاً حياً للمدن السكنية التي تتوفر فيها الجوانب الصحية والبيئية بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية" [15] . ولكن الكثير من الآراء والمواقف تعارض هذا الرأي وتعتبر أن التجربة تحتاج إلى مراجعة على جميع الأصعدة (سوء الطبيعة الجيولوجية التي بنيت عليها المدينة، نقص الصيانة، القرارات التي تهدد القاطنين بفقدان منازلهم بسبب نقص إمكانياتهم المالية). [16]
قد يكمن حل مشكلة السكن في التعمق في المواضيع التالية وفهم العلاقة بينها:
أي المناطق مرغوب بتشجيع النشاط الاقتصادي وبالتالي السكني فيها؟
وهذا الأمر يتطلب الانتباه إلى أهمية تسهيل حركة العمالة ودراسة العلاقة بين البناء السكني وما قد يسببه من آثار سلبية للمناطق الزراعية والبيئة… لا نعتقد بجدوى معالجة مشاكل السكن من خلال هدم المخالفات وبناء أحياء منظمة فيها (سواءً تم ذلك عن طريق شركات استثمارية متخصصة أو تحفيز السكان على التنسيق الجماعي في تشييد محاضر نظامية). هذا النوع من الحلول يعني الخضوع للأمر الواقع والاستمرار في السياسات المركزية التي تعطي دوراً محورياً للمدن الكبرى؛ مما يعني تأكيداً على الهجرة من الريف إليها.
يكمن أساس المشكلة في العقدين الأخيرين في مشكلة توفير فرص العمل في مختلف أنحاء القطر. إلا أن تمركز الفعاليات في المدن الكبرى أدى إلى ذلك الزحف السكاني الكبير إليها وتسبب بالعديد من المظاهر السلبية (نقص المياه وازدحام وتلوث…). وبالإضافة إلى ذلك فقد أدت الهجرة الكثيفة باتجاه المدن الكبيرة ومحدودية المساحات المقررة للبناء السكني إلى العديد من المشاكل. فقد تزايدت أسعار الأراضي بشكل غير منسجم بين محافظة أو منطقة سكنية وأخرى. وتزايد السكن العشوائي في مناطق معروفة بعدم استقرارها الجيولوجي. وقد كشف أحد التقارير عن وجود منطقة خطرة في دمشق بطول عشرة كيلومترات وعرض 20-30 متراً، وتمتد من منطقة مشفى تشرين حتى مزة 86 مروراً بعش الورور وبرزة والشيخ محي الدين وركن الدين والمهاجرين. ويمتد تحت هذه المنطقة ما يسمى بنطاق التكهف تحت السطحي وهي مغاور وكهوف تشكلت من انحلال طبقات الكلس الغضاري بين طبقات أشد قساوة، وساهم الإنسان في زيادة هذه التجاويف. وتم تشييد الكثير من المباني فوق هذه المنطقة الخطرة وفي بعض الأماكن لا يفصل بين التجاويف المذكورة وسطح الأرض سوى عدد أمتار. [17]
نظن بأن خلق نشاطات جديدة وفرص عمل مناسبة في المناطق الأخرى (سهل الغاب والساحل…)، لا بد وأن يؤدي إلى هجرة عكسية تلقائية من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة أو إلى المدن الجديدة. وقد يفيد النقل التدريجي للنشاط الاقتصادي وبالتالي للسكن الكثيف إلى المناطق المعتدلة في توفير الطاقة صيفاً (حيث ستنخفض الحاجة للتكييف) وشتاءً (إذ ستنخفض الحاجة للتدفئة). وسيسمح هذا التوجه بتوفير مساحات خضراء للتنزه والسياحة الضرورية لجميع المواطنين(دون الحاجة لكميات مياه كبيرة في السقاية وما ينتج عن ذلك من استنزاف للمياه الجوفية).
هل نتبنى سياسات تشجيع تملك أم استئجار؟
تساعد الإجابة على هذا السؤال في تحديد سياسة القروض السكنية وإمكانية توجيه هذه الموارد إلى استثمارات مختلفة. يبين تعداد المساكن عام 1994 أن حيازة الملك هي الأكثر انتشاراً في المساكن في سوريا.
|
1994 |
1970 |
حيازة السكن بالملكية |
|
87.9% |
82.8% |
على مستوى القطر حيث |
|
83.1% |
68.7% |
حضر |
|
93.3% |
93.1% |
ريف |
وتدل هذه الأرقام على التغير الجذري الذي حدث في طريقة التعامل مع موضوع السكن (مع الانتباه لعدم دقة الأرقام وانتشار ظاهرة السكن العشوائي). فقد تميزت فترات ما قبل الستينات بوجود إمكانية الاستئجار في ظل ضوابط واضحة المعالم. وهذا ما أزاح هاجس مشكلة السكن عن كاهل المواطن العادي. أما السنوات السابقة فقد عانت من عدم وضوح العلاقة بين المالك والمستأجر وبين النظام الضريبي وريع العقارات وغيرها من الثنويات التي تتميز بها البلدان النامية. وأدى كل ذلك إلى عزوف المالكين عن تأجير منازلهم خشية عصيان المستأجر بها، وإلى تردد المستأجرين في الاستمرار بعقود مؤقتة. وهذا ما دفع بالكثير منهم للبحث عن ملكية مساكنهم بدلاً من استئجارها. ونظراً لغلاء أسعار المساكن النظامية في المدن الكبرى (وخاصةً دمشق) وعدم منطقيته مقارنةً برواتب المستأجرين، فقد وجد هؤلاء في السكن العشوائي فرصةً ذهبية. فنما هذا القطاع بسرعة كبيرة وقاربت نسبة سكان المناطق المحظورة على السكن 40% في المدن الكبيرة. [18]
ولو قارنا وضع السكن في سوريا مع دولة متقدمة مثل فرنسا لوجدنا أن عدد المساكن فيه29 مليون مسكناً حيث 24 مليون مسكناً رئيسياً منها 11 مليون مسكناً جماعياً. وتبلغ نسبة المساكن المستأجرة 40% من المجموع الكلي. [19]
أما بالمقارنة مع ألمانيا لوجدنا أن عدد المساكن فيها 35.9 مليون مسكناً منها 28.9 مليون مسكناً في الولايات القديمة حيث تصل نسبة المساكن التي يملكها ساكنوها إلى 41.7%. أما نسبة الملكية في الولايات الجديدة فتصل إلى 27% (حسب إحصائيات 1993). [20] وهذا يدل بشكل واضح على أن هذا البلد يتبنى سياسات سكنية تشجع الاستئجار.
فإذا كانت فرنسا وألمانيا (المتميزة بالدخل المرتفع للفرد فيها مقارنةً بسوريا) تشجع هذا التوجه، فإن ذلك يدفعنا إلى الاستغراب أمام تشجيع سياسات التمليك في سوريا ذات الدخول المنخفضة نسبياً والتي تحتاج لموارد مالية ضخمة لتملك المساكن مقارنةً بتشجيع الاستئجار وتوظيف الموارد الفائضة في مجالات تنموية أخرى.
إن تشجيع السياسات التأجيرية يعني إمكانية الحصول على الموارد الكافية للترميم والصيانة والتحديث. ولكن قوانين الإيجار لم تأخذ بالاعتبار إلا الناحية الاجتماعية فعمدت إلى إقرار الأجور المتواضعة جداً دون دعمها من قبل الدولة، ولم تنظر إلى المشاكل الاقتصادية التي ظهرت تدريجياً خلال العقود السابقة. ولو قارنا بين معالجة مشاكل السكن في سوريا مع ألمانيا، لوجدنا أن السياسات السكنية في سوريا غالباً ما كانت منقوصة وتتم على حساب شريحة معينة من السكان. ففي ألمانيا "يعتبر السكن من الحاجات الأساسية للإنسان. لذلك يحق لكل مواطن في ألمانيا، لا يكفي دخله لاستئجار مسكن ملائم، أن يحصل بحكم القانون على علاوة سكن. وتدفع الدولة هذا التعويض…كجزء من الإيجار أو لتغطية جزء من نفقات السكن الذي يسكنه صاحبه. غير أن تعويض السكن يقتصر على ذوي الدخل المحدود". وفي نهاية 1995 بلغت تعويضات السكن في ألمانيا 6.1 مليار مارك ألماني.
دور السياسات الضريبية والمصرفية
تُستخدم السياسات الضريبية والمصرفية بشكل فعال في الدول الأخرى لتوجيه الاستثمارات باتجاه القطاعات المناسبة لتوجهات الدولة. إلا أن واقع الحال في سوريا حيَّد هذه الإمكانية منذ زمن بعيد. فالتخمين المعتمد يعود إلى سنوات السبعينات. وهو أخفض بكثير من القيمة السوقية، مما سمح لتجار العقارات بتحقيق أرباح خيالية من خلال المضاربة. ولا يمكن زيادة التخمين المعتمد حالياً في وزارة المالية نظراً لضعف الدخول وعدم إمكانية تسديد الضرائب إذا ما طُبقت على القيم الحقيقية. وهذا ما أدى إلى قصور المنظومة الضريبية وضعف الإيرادات رغم الأرباح الكبيرة التي تم تحقيقها في تجارة البناء في السنوات السابقة.
نحن بحاجة إلى نظام ضريبي أكثر فاعلية يسمح للدولة بتوجيه الرساميل المتوافرة بالاتجاهات الصحيحة. ورغم أهمية القطاع السكني، فإننا نعتقد بوجود أهمية خاصة لسياسات تشجيع الاستئجار لمساكن يتم تمويل بنائها بسعر التكلفة، مما يوفر على الدولة والبنية المصرفية كمية كبيرة من الرساميل يتم توجيهها إلى القطاعات الحيوية الأخرى التي توفر فرص عمل دائمة ومنتجة فعلياً ومحركة للاقتصاد على الأمد البعيد.
ويمكن تمثيل هذه الفكرة بالشكل التالي:
تعتمد السياسة الحالية على توجيه التمويل المصرفي إلى القطاع العام بشكل أساسي، وأما بالنسبة للقطاع السكني فيتم توجيه التمويل المصرفي (المتميز بضآلته النسبية وصعوبة الحصول عليه) لصالح:
r صغار المستثمرين الراغبين ببناء مساكن شخصية (مما يتسبب بهدر الوفورات الممكن تحقيقها في حال بناء تجمعات سكنية منظمة).
r والمواطنين الراغبين بشراء مساكن جاهزة (وما يترتب على ذلك من دفع مبالغ إضافية كبيرة مقارنةً بسعر التكلفة خاصةً في فترات المضاربات مثل نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم).
نحاول من خلال الشكل أعلاه عرض وجهة نظرنا في مجال السياسات السكنية في سوريا وآليات الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب:
نفترض أولاً أنه ضمن الشروط الحالية للتمويل المصرفي المتاح لقطاع البناء يقع العرض في المستوى SS. أما الطلب على السكن الذي يعبر عن الاحتياجات الفعلية للسكن (كما افترضناها في بداية المقال) فيقع في المستوى D”D”. وهذا ما يجعل نقطة التوازن في الموقع X حيث يكون عدد المساكن المعروضة (Q”) مساوياً للكمية المطلوبة والسعر عند P”.
ولكن نقص الإمكانيات التمويلية المتاحة للمواطنين تجعل الطلب أقل بكثير (في المستوى D’D’) وهذا ما يتسبب بانخفاض الكمية المعروضة إلى Q2 وانخفاض السعر إلى P2.
ونظراً للضغوط الاجتماعية، تقوم الدولة حالياً بالتركيز على جهة الطلب عن طريق منح القروض المصرفية إلى المواطنين الراغبين بالحصول على سكن. وبزيادة تمويل الطلب يصبح المنحني في DD مما ينقل نقطة التوازن إلى المستوى A حيث تزداد الكمية المعروضة إلى Q1 ويزداد السعر أيضاً إلى P1. ونفترض أن هذا الوضع التوازني يُعبر عن الواقع الحالي لقطاع السكن في سوريا. فالكمية المعروضة أقل من الطلب الكامن الفعلي الذي افترضناه في المستوى Q”.
والآن نفترض أن الدولة قد قررت الاعتماد على تفعيل جهة العرض بدلاً من الطلب. تستطيع الأموال المخصصة لتمويل شراء المساكن الجاهزة أو على الهيكل (الموزعة على المواطنين) تمويل أعداد أكبر بكثير من المساكن بسعر التكلفة. وتصبح التوجهات نحو استثمارات سكنية بقصد التأجير واستفادة المستثمرين من ريع الإيجار بدلاً من أرباح البيع. وهنا تأتي أهمية توفير مزايا ضريبية مناسبة لتشجيع وتحفيز المستثمرين على توظيف الجزء الأكبر من أموالهم في مساكن للإيجار وليس للبيع. في هذه الحالة سينتقل منحني العرض إلى S’S’ وتصبح الكمية المعروضة أكبر بكثير (Q3) وأما الأسعار فستنخفض بشكل كبير إلى P3.
وهنا لا بد لنا من التنويه إلى النقاط والتعليقات التالية التي يجب أخذها بالاعتبار في ظل أي سياسة سكنية تنموية:
r هناك أهمية كبيرة لانسجام وتناغم هذه التوجهات التمويلية والضريبية مع الرؤيا المتكاملة والمستقبلية لوجه سوريا العمراني، ولتوزيع الفعاليات الاقتصادية في مختلف المناطق السورية بما يخدم المسيرة التنموية الوطنية. ويتم التركيز بشكل كبير على أن مثل هذه التوجهات تهدف إلى إعادة توزيع الثروة بطريقة تضمن الحصول على المسكن الصحي المناسب في أي مدينة وبتكلفة متناسبةٍ مع الدخل (سواءً كان المسكن ملكاً أو استئجاراً).
r يمكن من خلال تشجيع سياسات الاستئجار تسهيل حركة العمالة بين المحافظات السورية. فالواقع الحالي يشير إلى ارتباط المواطن بالمحافظة التي يملك فيها مسكناً أكثر من ارتباطه بفرص العمل المتوفرة في أماكن أخرى. ومن جهةٍ أخرى، لا يستطيع المواطن استئجار مسكن بشروط صحية مقبولة في المدن الكبيرة بسبب غلاء الأسعار والمواصلات. وإذا توفرت له فرصة عمل مقبولة فإنه يقوم بالاستئجار في مناطق السكن العشوائي (وما يتبع ذلك من مظاهر سلبية تم الإشارة إليها أعلاه).
r لا يؤدي تمركز الاستثمارات في العقارات إلى "شفط" السيولة من القطاعات الأخرى فحسب، وإنما يؤدي أيضاً في حالة عدم تنفيذ البناء ضمن خطة متكاملة إلى خلق مشاكل نحن في غنى عنها خاصةً في مجال البيئة والمرور وأمن وسلامة المواطنين، فضلاً عن صعوبة تخطيط الاحتياجات الأساسية لهم من مدارس وحدائق وطرقات ومراكز صحية وغيرها من أساسيات الحياة الكريمة…
r ولكن لا بد من التنويه إلى أن تشجيع حركة الاستثمار المكثف والمنظم في قطاع البناء يجب أن تترافق بتسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية ومراقبة لصيقة لشروط الأمان ومنع الممارسات الإدارية الفاسدة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين الكامنين بغية تشجيع المنافسة الشريفة.
r قد تساعد عملية التركيز المضبوط لجهة العرض السكني في تخفيض الأسعار بشكل كبير وتحريك الاقتصاد الوطني على الأمد المتوسط والقصير، كما قد تساعد عملية تخفيض الأسعار (إن كانت ملموسة) في توحيد أسعار العقارات في السجلات الرسمية مع السعر السوقي.
r لا بد أن يتساءل القارئ عن الناحية الاجتماعية في قبول احتكار السكن من قبل أقلية أو أعداد محدودة من المواطنين الميسورين واعتماد الباقي على الاستئجار؟ تعتمد الإجابة على هذا التساؤل على مستوى دخل الفرد وقدرة صانعي القرار على تخفيض النسبة المطلوبة من الدخل المخصصة للإيجار (مع الأخذ بالاعتبار التباين بين أسعار السكن في الريف والمدينة). من جهتنا نعتقد بأن توفير السكن في جميع المدن بأسعار مقبولة وضمن مخططات تنظيمية وعمرانية مناسبة لعملية التنمية الشاملة تؤدي إلى تحقيق عدالة اجتماعية لا تقارن بواقع الحال عندما يضطر المواطن لتخصيص معظم (أو أكثر من) راتبه للسكن.
نوعية المساكن المستقبلية من الناحية المعمارية؟هل تطمح سوريا إلى زيادة المساكن ذات الطبيعة الشاقولية (أبراج) أم المساكن المنفردة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة ومصادر تمويلية أكبر نسبياً؟ وهل سيتم التركيز على النواحي العملية أم الجمالية أم كليهما؟ وما هي النتائج المحتملة لكل منظومة وما يتبعها من خدمات ضرورية: حدائق ومرائب ومكان للمصاعد وممرات للمعاقين وأمكنة لصناديق البريد وأمكنة لتجهيزات التدفئة المركزية والمناور الخ. ونعتقد بضرورة أخذ معطيات الحداثة بالاعتبار، فعلى صعيد الاتصالات هل نعتمد مبدأ الاشتراكات بشبكة متكاملة أم نسمح بأطباق وما يستلزم الأمر من حجز أماكن فوق المباني وتخصيص أنابيب للأسلاك بدلاً من تركها مدلاة على الجدران…
نطرح هذه التساؤلات بسبب عدم تحديث السياسة السكنية بما يتلاءم وتغير الظروف وتبدل متطلبات المستأجرين أو المالكين الكامنين؛ ودون مراعاة جدية ودراسات معمقة لمختلف النتائج السلبية المحتملة جراء مختلف القرارات والسياسات المطبقة.
حسب العرف الحالي، تتألف الشقق السكنية من غرفتين كحد أدنى وإن كانت المساحة صغيرة جداً. ورغم وجود طلب كامن كبير جداً، لم تنتشر الأبنية التي تحوي غرفاً منفردة متكاملة الخدمات (أي نظام "ستيوديو" مجهز بزاوية مطبخ و"دوش"). وهذا النوع من السكن مهم جداً من أجل الشريحة الكبيرة من الشباب. فمعظم هؤلاء يتأخرون بالزواج حتى الثلاثينيات من عمرهم. وقد يكون في هذا النوع الجديد من العمارة السكنية حل لمشكلتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم وتطلعاتهم (من حيث المتطلبات السكنية الأساسية وكذلك مبلغ الإيجار).
وما زالت معظم التجمعات السكنية الجديدة تفتقر للإجابة الشافية على التساؤلات المشار إليها أعلاه.
أما على مستوى الحي أو الضاحية فيمكن أن نورد الملاحظات التالية:
r تعاني الكثير من مناطق السكن العشوائي من غياب المراكز الصحية ومخافر الشرطة والمدارس وغيرها من الخدمات الضرورية.
r يمكن بسهولة ملاحظة المعاناة من التلوث والازدحام الذي تحدثه حافلات نقل طلاب المدارس في مناطق دمشق القديمة التي تتميز بطرقها الضيقة ووجود العشرات من المدارس المنتشرة بين أروقتها. وإذا كانت الحافلات موجودة بالنسبة لهذه المناطق، فإن طلاب المدارس في عش الورور يقومون بالرياضة الصباحية قبل الدوام نظراً لعدم توفر وسائل النقل أو لغلائها النسبي بالنسبة لأهاليهم وكذلك بُعْد المدرسة والطبيعة الجبلية القاسية في هذه المساكن.
r ما زالت النواحي الجمالية ضعيفة ولا تلبي الاحتياجات. ويمكن لجميع المدن السورية أن تستفيد من مشاريع التخرج المميزة في الكليات المعنية (عمارة، فنون جميلة الخ) في تخطيط وتزيين المرافق والساحات العامة بتمويل من غرف التجارة والمنشآت السياحية.
r بغض النظر عن انتشار"الأكشاك" و"البسطات" على الأرصفة، فإن ما يسترعي انتباه جميع الوافدين إلى بلدنا هو الانتشار الكبير لظاهرة المحلات التجارية والورشات في الطوابق الأرضية لمعظم الأبنية. تؤكد هذه الظاهرة على عدم النضج الحقيقي باتجاه مفهوم المدن الحديثة التي تفصل بين الفعاليات التجارية (بتجميعها في مراكز تجارية كبيرة على الأطراف) والتجمعات السكنية التي تحتاج إلى الأجواء الصحية (راحة وهدوء ونقاء). وهنا لا بد من التنويه إلى أن هذا الفصل بين مراكز السكن من جهة ومراكز النشاط التجاري والصناعي يستلزم مجموعة من الشروط غير المتوفرة حالياً (مخططات تنظيمية وعمرانية ووسائل نقل متطورة بالإضافة إلى مستويات دخل فردية عالية نسبياً…). إن ذلك لا يمنع من التفكير بعمق في مخططات تنظيمية وعمرانية مستقبلية تترجم الرؤية المنشودة لشكل سوريا المستقبلي، وذلك بالتنسيق مع مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة.
كما يستلزم الأمر تحديد الجهات المعنية بالاستثمار في عملية بناء المساكن. هل هي جهات القطاع الخاص أم الجمعيات أم جهات القطاع الإنتاجي الراغبة بجذب الكوادر إليها من خلال توزيع المساكن عليهم بالطرق المختلفة (مجاناً أو بأسعار رمزية، ملكاً أو استئجاراً…)؟ وهذه التساؤلات تستدعي إعادة تعريف دور الدولة والقطاع العام على ضوء المستجدات الحالية من انفتاح الأسواق والعولمة...
خاتمة
ينبغي التفكير في سياسات ضريبية ومصرفية مختلفة. كما أن هناك ضرورة لتحضير مخططات تنظيمية وعمرانية مختلفة جذرياً على مستوى القطر، بحيث يتم إنشاء مدن حديثة في مناطق ذات مناخٍ مقبولٍ، وتتلاءم مع متطلبات العصر، وتترافق مع مناطق صناعية متاخمة، وتتوفر فيها الخدمات المنظمة. نتوقع أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الهجرة العكسية (من المدينة إلى الريف)؛ ولكن يتوجب علينا أن نأخذ بالاعتبار العديد من النقاط الهامة مثل: كميات الماء المتوافرة والبيئة وتأثر القطاعات الحيوية فيما بينها…
ومن المفيد التنويه إلى تجربة القاهرة في خلق مناطق صناعية وسكنية ضخمة بجوار القاهرة بقصد تخفيف الازدحام والتلوث فيها وتوفير فرص عمل.. لم تستطع هذه المناطق، رغم مساهمتها بالنمو الاقتصادي، تخفيف الضغط السكاني لأن تواجدها الجغرافي القريب نسبياً دفع بالكثيرين إلى التنقل اليومي جيئةً وذهاباً وهذا ما تسبب بمزيد من الازدحام والتلوث. [21] من هذا المنطلق، يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتوجيه الاستثمارات القادمة إلى مناطق جاذبة صناعياً وسكنياً دون التوسع بجوار المدن الكبيرة مثل دمشق أو حلب.
دمشق 12/6/2001
د. دريد درغام
[1] دريد درغام : دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس العاشرة؛ مدرس في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. محاضرفي دبلوم الدراسات العليا في كلية الاقتصاد-جامعة دمشق.
[2] المسكن المعتاد هو مبنى أو جزء من مبنى مُعدٌّ أصلاً لسكن الإنسان ويتكون من غرفة أو مجموعة من غرف المعيشة وملحقاتها وقد يكون مشغولاً أو خالياً أو انتهى بناؤه على الهيكل.
[3] وهذا تقريب مقبول إذا علمنا أن نسبة سكان سوريا ممن هم أقل من 20 عاماً تصل إلى حوالي 55%.
[4] لمزيد من التفاصيل حول هذا الاستثمار في سوريا، انظر محاضرة السنة السابقة "الإنفاق الإنمائي العام والخاص في سوريا" في ندوة الثلاثاء الاقتصادي 23/5/2000.
[5] كنا قد أثبتنا أن توفير العمل لكل من هو قادر عليه (من زاد عمره عن 19 عاماً ذكوراً وإناثاً) يستلزم خلق 400 ألف فرصة عمل سنوياً خلال السنوات العشر الآتية. ولكننا افترضنا أن المطلوب هو تامين نصف العدد فقط. وجدير بالذكر أنه ضمن منهجية مقالنا في سيما الأولى، وبتحديث الأرقام حسب المجموعة الإحصائية لعام 2000 فإن العدد يصل إلى 452 ألف طالب عمل خلال العشر سنوات القادمة! أي أن المصلوب هو خلق أكثر من 225 ألف فرصة عمل بشكل وسطي في كل عام من الأعوام العشر القادمة. لمزيد من التفاصيل حول منهجية التقدير انظر مقالنا في ندوة سيما الاقتصادية الأولى عام 1999.
[6] خلال عقد التسعينات، لم يتجاوز متوسط التوظيف السنوي في وزارات الدولة المختلفة 20 ألف فرصة عمل حيث كان متوسط حصة القطاع العام الصناعي 3000 فرصة عمل. وتراوحت حصة القطاع الخاص بين 20-30 ألف فرصة عمل. وهذا يعني عجز كبير في خلق فرص العمل الكافية في القطاعات الرسمية. وهذا ما دفع إلى الاتكال المتزايد على دور القطاعات غير المنظمة (تنامي دور اقتصاد الظل).
[7] لمزيد من التفاصيل، انظر صفحة 7 في ملف الإثنين من جريدة البعث 28\2\2000.
[8] لم نجد في الإحصاءات الرسمية أية إشارة واضحة إلى المساحات السكنية الجديدة التي يمكن أن تكون قد حلت مكان مساحات قديمة (إعادة بناء المنازل أو استبدال المنازل التقليدية بأبراج سكنية..). وهذا الأمر قد يتسبب في وجود بعض الارتيابات في تقديراتنا ولكنه لا يؤثر على المنهجية العامة خاصةً وأننا نأخذ دوماً الموقف التشاؤمي في تقديراتنا كيلا نوصف بالمغالاة.
[9] قد يتساءل البعض عن التباين بين العدد الذي ذكرناه بخصوص الطلب على السكن (65 ألف) من جهة، والعدد المذكور هنا 90 ألف. وهنا ننوه إلى أن السبب قد يعود إلى وجود السكن العشوائي وإلى تزايد ظاهرة تخصيص غرفة أو أكثر لأحد أفراد العائلة وتجهيزها بعداد خاص… ومع ذلك فإن تقديراتنا تبقى منطقية ضمن سعر المتر المبالغ في تخفيضه من قبلنا.
[10] المصدر: "المحاسبة القومية" لـ إديث أرشامبو، دار نشر إيكونوميكا 1994 ص.188
[11] ملف الإثنين 28\2\2000، صفحة 9
[12] نقلاً عن جريدة البعث صفحة 9 ملف الإثنين 28\2\2000.
[13] لمزيد من التفاصيل حول الفساد الإداري ودوافع نشوئه وانتشاره انظر محاضرة الثلاثاء الاقتصادي في 23/2/1999.
[14] حسب ما ورد في مقال بيتر دروكر www.theatlantic.com/issues/99oct/9910drucker2.html
[15] السكن والإسكان، علي عبود، ملف الإثنين في جريدة البعث 21/6/1999.
[16] لمزيد من التفاصيل انظر جريدة الدمري "ما هكذا يكون الوفاء لعمال سد الفرات" العدد 12 الإثنثن 21/5/2001 صفحة 7
[17] لمزيد من التفاصيل، انظر جريدة الدومري "خطر الانهيارات يهدد آلاف الناس" العدد 12 الإثنين 21/5/2001
[18] ملف الإثنين في جريدة البعث 21/6/1999 و28\2\2000.
[19] لمزيد من التفاصيل حول سياسات السكن في فرنسا يمكن العودة إلى:
Le compte du logement- rapport a la commission des comptes du logement 2000
[20] لمزيد من التفاصيل انظر "حقائق عن ألمانيا" من منشورات دائرة الصحافة والإعلام التابعة لحكومة ألمانيا الاتحادية 1998.
[21] ندوة شركة كيمونيكس حول الحلول البيئية المتكاملة "التجربة المصرية" 9-10كانون أول 2000 الميريديان.