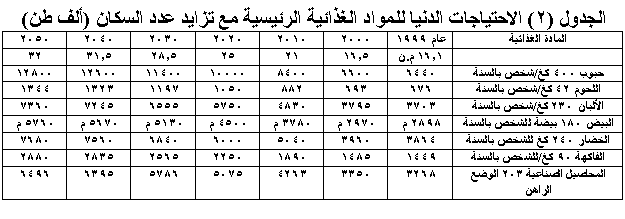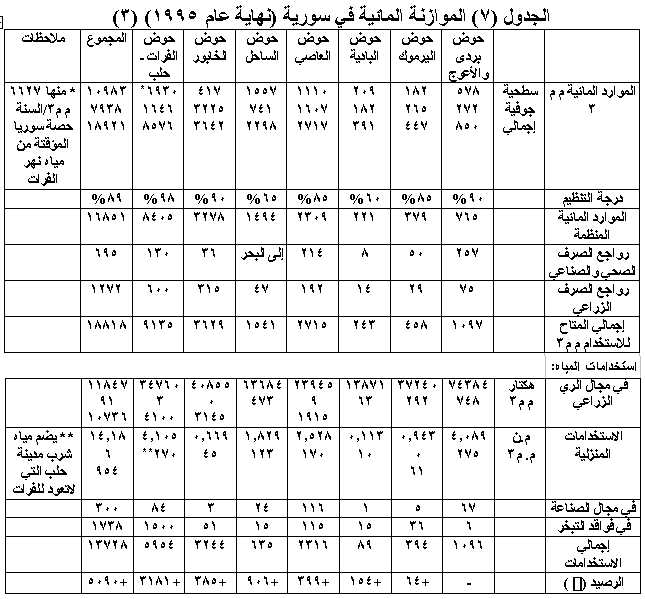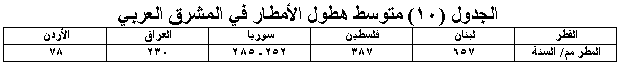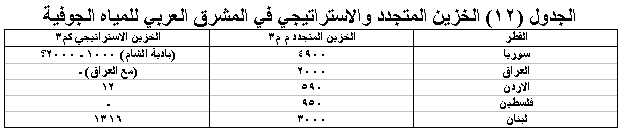|
قال الله تعالى:
"وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا
مكين أمين"
ـ سورة يوسف 54 ـ
"نحو
استراتيجية مائية في سوريا"
ندوة الثلاثاء الاقتصادية الثالثة عشرة
16/5/2000
الأستاذ الدكتور شبلي الشامي
1 ـ مبررات الدراسة (المقدمة):
1 ـ 1 ـ ندرة المياه في الشرق الأوسط كانت وراء حضارات الشرق الأوسط (في
الهلال الخصيب) أو على ضفاف نهر النيل حيث استقرت الحضارة حول مصادر المياه عموماً
فحضارة ماري ذات الألفي مهندس ري والتي استقرت على ضفة نهر الفرات قد جعلت شعار
مصلحة أعمال المياه والري لديها [بأن المياه هي الحياة السرمدية] وذلك مصداقاً
لقوله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي" ولا تزال آثار تلك الحضارات
قائمة للآن مثل تقسيم نهر بردى لفروع سبعة مع شبكة صرف لمياه الري في الغوطة وسد
مأرب وبئر زمزم والتي تمثل أشكالاً لإستثمار المياه في المنطقة العربية والتي
ترافقت بتطور الشرائع والقوانين التي تعنى بشؤون المياه كشريعة حمورابي وأرنمو
وقانون أشنونة التي تعود إلى حوالي أربعة آلاف سنة مضت كما تعكس قصة طوفان نوح
عليه السلام الخوف من عدم القدرة على التحكم بالمياه، وحالياً لو استعملت مياه
النيل وشط العرب وبغض النظر عن حقوق الآخرين (كالدول الأفريقية على نهر النيل
وتركيا على نهري الفرات ودجلة) فإن المياه كلها أقل من أن تفي بحاجاتنا حالياً
ومستقبلاً إلا إذا استعملت المياه لأكثر من مرة وباستعمال تقنيات رفيعة للمعالجة
او استعمال هندسة المورثات لزيادة الانتاج أو تحلية مياه البحر او قطف رطوبة
الهواء...(1).
1 ـ 2 ـ المناخ والذي يميل ليصبح أكثر جفافاً مع ظاهرة الدفيئة (البيت
البلاستيكي) لأغلب أقطار المنطقة وتبدو الأمطار في المناطق الجبلية والساحلية
مقبولة حيث يقدر الهطول المطري بـ 600 ـ 1000 مم سنوياً ليتحول هذا الهطول المطري
إلى تبخر أو يجري في المسيلات والانهار وبالتالي فانتشار وتوسع ظاهرة التصحر نتيجة
لتدهور المناخ يستوجب تحسين البيئة لمكافحة التصحر ومن أفضل وسائل تحسين البيئة.
الاستعمال المتاح والأفضل لمصادر المياه المتوفرة.
1 ـ 3 ـ تزايد السكان بمعدل أكثر من 5% احياناً وحوالي 4% حالياً أدى إلى
ارتفاع عدد سكان سورية من 0.5 مليون في بداية القرن العشرين إلى 3 مليون في منتصفه
إلى حوالي عشرين مليوناً في نهايته ومع انهيار الاتحاد السوفيتي والهجرة المستمرة
لليهود منه إلى المنطقة فازداد عدد سكان اسرائيل وأصبح اكثر من ستة ملايين نسمة
ومع ارتفاع مستوى المعيشة والاستهلاك في اسرائيل فقد ازداد الضغط على مصادر المياه
واستهلاك الغذاء ومع انهيار الاقتصاد الهش الحرج لأغلب أقطار الشرق الوسط لأنها
ليست كلها أقطار نفط غنية... مما يستوجب حلولاً واتفاقيات تضع التجمعات السكانية
في المنطقة أمام امكانيات أكثر استقراراً.
1 ـ 4 ـ مع تحسن اسعار النفط والازدهار الذي رافق ذلك في السبعينات من
القرن العشرين والذي انعكس على تحسن مستويات المعيشة للتجمعات المحلية مما أدى
لاستهلاك أكثر من المياه للأغراض المنزلية فقد كانت احتياجات الفرد في أوائل
السبعينات من 25 ـ 35 ليتر يومياً واستمر ارتفاع الاستهلاك المنزلي حتى تجاوز 150
ليتر يومياً وذلك يستوجب تدوير المياه (اعادة استعمالها) باستعمال المعالجة
المتقدمة أو بانشاء شبكتين لإمداد المياه بحيث تحتوي شبكة على المياه الصالحة
للشرب والطبخ وتحتوي الشبكة الأخرى على المياه للاستعمالات الأخرى مثلاً، أو
اللجوء إلى حلول بديلة متعددة ودراسة الحل الأمثل...
1 ـ 5 ـ في سوريا سبعة أحواض مائية: الفرات ودجلة بين سورية وتركيا والعراق
والعاصي بين لبنان وسوريا وادعاء تركيا بمصبه واليرموك بين سوريا والاردن ولبنان
وفلسطين وادعاءات اسرائيل وحوض دمشق الذي يشمل بردى والاعوج بين سوريا وجزء صغير
من لبنان وحوض حلب بين سوريا وتركيا وحوض الساحل السوري وعلاقته بمواثيق البحر
الابيض المتوسط (كاتفاقية برشلونة وغيرها) وحوض البادية هو جزء من بادية بلاد
الشام؟ وهذه الاقطار المتجاورة تخضع للتنافس الدولي والاقليمي والوطني الكامن
لصراع مستقبلي.
1 ـ 6 ـ انعدام الثقة المستمرة والشعور المريض بين اغلب اقطار الشرق الأوسط
واثبتت الحروب العربية الاسرائيلية وحرب الخليج الأولى أن الصراع بين القوميات قد
وصل إلى الصراع المسلح بينما أظهرت حرب الخليج الثانية أن الصراع ليس بين القوميات
المختلفة فقط وإنما بين العرب ـ العرب أيضاً وذلك يستوجب الوصول إلى حلول واستقرار
بشكل ما.
1 ـ 7 ـ واستمراراً لأجواء عدم الثقة فلا يوجد تنظيم لاستعمالات المياه بين
الاقطار المتشاطئة وبعد مباحثات لأكثر من 50 سنة بين تركيا وسوريا والعراق فلا يوجد
اتفاق جدي حتى الآن؟ وذلك يقتضي الرجوع إلى القوانين الدولية والحالات المشابهة
وايجاد الحلول التي تساعد على الاستقرار.
1 ـ 8 ـ الاستقرار السياسي مرهون بالاستقرار دولياً واقليمياً ومحلياً
وبعدد من العوامل الداخلية المتعلقة بالبنية الفكرية والثقافية والاقتصادية وذلك
يؤثر على التزاحم لاستخدامات المياه فكلمة rival أتت من اللاتينية rivalis وتعني
(المشاركة مع الاخرين على نفس الجدول) ولكنها حديثاً تستعمل للتنافس بالمقياس
الوطني والدولي، إضافة لأثر التقانة على وفرة المياه للنباتات والاحياء الأخرى
plethora of plant، وعلى مشاريع أنهار العالم منذ سنة 1945 والتي أدت لقلب ونقل
وحجز وصرف وسد جريان الأنهار التي كانت تجري على مدار آلاف السنين كمياه سطحية أو
المياه الجوفية بطول أميال تحت السطح والتي تدعى بالأقنية (أو الفجارات) canat
والتي كانت تمد المياه لمدينة صغيرة أو لقرية فقط ومع استعمالات تقنيات الضخ فقد
جفت آلاف الاقنية في المنطقة وحرمت آلاف التجمعات السكانية من الاستقرار الاجتماعي
والاقتصادي الذي اعتادوا عليه منذ فجر التاريخ مما خلق عشوائيات متنافرة وكامنة
لانفجارات سياسية مستقبلاً؟
1 ـ 9 ـ ظاهرة تملح التربة نتيجة لتبخر مياه الري بحرارة الشمس ولأن المياه
ترمي املاحاً اضافية على الأراضي فيرتفع تركيز شوارد المعادن minerals وتجف على
السطح كمتبقي يشبه الكعكة أو تنحل مع المياه الجوفية لتسمم جذور النباتات وتملح
الأراضي يستوجب مزيد من المياه لاستمرار الانتاجية. لذلك تتطور تقنيات استعمال
المياه المتملحة عبر الأغشية أو الديلزة أو القلع بالمحاليل أو التناضح العكسي...
أو التفاعلات الكيميائية، الفيزيائية، البيولوجية... واستعمالات التقنيات الحديثة
قد أصبح مألوفاً بشكل ما لاستخدامات المياه المنزلية ولكن مازالت الاستخدامات
الأخرى تصطدم بحاجز الكلفة.
ولكن مع المزيد من البحث فقد تصبح الكلفة معقولة لأن المياه الجوفية المتملحة أو
السطحية من أهم مصادر المياه المتجددة لمناطق البدو والمراعي...
1 ـ 10 ـ مشاكل ما بعد ضخ النفط فمثلاً تضخ السعودية 18 بليون م3 من المياه
الوقودية fossil water بالسنة ومع زيادة التجهيزات التقنية والتحكم الانساني على
الانظمة الطبيعية فستبقى مشاكل ما بعد ضخ النفط؟ (2) اضافة للتنافس على هذه
المصادر الذي قد يطور الصراع في المنطقة بين الاقطار المختلفة... ومع ازدياد أهمية
المياه كمصدر طبيعي فقد يكون وقف امداد المياه عن احدهم سبباً يشعل الصراع في
الشرق الاوسط بطريقة سريعة كالحالة الراهنة لحوض الفرات ودجلة (تركيا وسوريا
والعراق) ولحوض اليرموك (سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ الاردن ـ اسرائيل) ولأن تداخل
المياه السطحية والجوفية والموازنة المائية وضخ المياه الوقودية يستوجب ايجاد الحلول
المناسبة قبل اندلاع الصراع المسلح... لأن المسائل الدولية واحتكاكاتها وتنافسها
على المياه الموجودة يزداد اهمية مع ندرة المياه.
لذلك تزداد الحاجة لاستراتيجية وطنية مثل نقل المياه بمقياس كبير أو جر
المياه عبر الاقطار كمشاريع في الشرق الاوسط قابلة للدراسة والمقارنة...
ففي الشرق الاوسط يهطل 1/3 - 1/2 الهطول المطري على 10% من الأراضي ولذلك
تنقل بعض الحكومات في الشرق الاوسط للمياه عبر السوتيرات (نقليات المياه) وهذا
النقل بالسيارات لا يسبب الصراع ولكن النقل بكميات كبيرة عبر النواقل الهندسية
يسبب الصراع بين مناطق وأخرى داخل الدولة وبين الدول المتجاورة... خاصة وأن ازدياد
الطلب على المياه لدى المناطق التي كانت تمنح المياه قد يسبب صراعاً كامناً مع
إهمال بعض الحكومات لدراسة طلبات مانحي المياه، أو صراعاً على مسرح القرن الواحد
والعشرين بين الدول المغتصبة لأكثر من حقها والدول التي تنال كميات أقل، وكل ذلك
خاضع لنقاش يطول ويجب ربطه بالاحتياجات والتعويضات العادلة والمساومة بعيدة
النظر... فمثلاً بعد خلق اسرائيل سنة 1948 وجر المياه من المنطقة الشمالية الممطرة
إلى الجنوب الجاف بمسافة 270 ميلاً (432 كم) خلال ناقل المياه القومي ومع طلبات
واحتياجات أهل الشمال وعدم الوصول لخطط مياه وطنية واقليمية ودولية لاستعمالات
المياه في الاقليم فقد تغير المحصول التجاري الرئيسي من الموز للخضراوات الأقل
ربحاً...
التنافس على استعمال مياه دجلة والفرات خلق صراعاً كامناً ففي العراق انشئت
الحواجز والمنظمات للري منذ سنة 1950 وسحبت مياهاً كثيرة مما أعاق استمرار الملاحة
والنقل النهري بدجلة والفرات كما انشئت تركيا الكثير من السدود على الفرات (21
سداً) وسداً على دجلة في مشروع جنوب الأناضول وبالتالي فالسياسة المائية الرسمية
على نهري دجلة والفرات في تركيا وشمال العراق قد استهدفت الضغط على الاكراد
واحتوائهم حيث منبع النهرين العظيمين هو موطن الاكراد عبر التاريخ... وحجز المياه
بسد يسبب أثاراً على الحبس العلوي والسفلي للنهر فقد أغرق آلاف الهكتارات على
الحبس العلوي في تركيا وسوريا والعراق كما أن حجز الجريان الطبيعي يسبب قلة ترسيب
السيلت والطمي على الحبس السفلي لأن هذه المواد المخصبة تحجز في الحبس العلوي أو
بحيرة السد ففي حالة السد العالي مثلاً يلزم استهلاك نصف الطاقة الكهربائية
الناتجة عن السد لإنتاج المخصبات الصنعية البديلة عن السيلت والغضار التي كانت
تخصب وادي النيل... كما أن ترسب السيلت في البحيرة يسبب تآكلاً جدياً حول المنشآت
المقامة سابقاً على النهر كالجسور... وتناقص نوعية صيد الاسماك والاستيطان الحيوي
في مجرى النهر عموماً... إذاً الصراع المتعدد الاطراف على الانهار مأساة كامنة
كبيرة وأكبر الصراعات في الشرق الاوسط حول نهر الاردن وعلى طول مجرى دجلة والفرات
وصراع الدول العشرة على حوض النيل؟
1 ـ 11 ـ الاستشعار عن بعد لمصادر واستعمالات المياه
مع تقنيات GIS ذات صلة عميقة بموضوع هذه الدراسة. ففي أكثر دول المنطقة مراكز
للاستشعار عن بعد وبتكامل هذه المعلومات ضمن استراتيجية تتيح للجميع منافع مشتركة
فقد يكون الاستشعار عن بعد من أهم تقنيات هذا العصر لمعرفة الاحتياجات الدقيقة
ومعرفة ماهو متوفر فعلاً وبدقة وبالتالي ترسم المشاريع والسياسات معاً وبدون هدر
الوقت اللازم حول جدوى قاعدة المعلومات ودقتها فأكثر اسباب سوء التفاهم بين الاطراف
المتجاورة قد نتجت عن سوء التقدير (للاحتياجات والمصادر) وعندما تقدم المعلومات
الدقيقة تستقر الأمور باتجاه الحل المناسب لكافة الاطراف...
من هذه المبررات فلا بد من تحديد قيمة مواردنا المائية وكيفية التعامل معها
وادارتها واستثمارها ليتسنى لصانعي القرار اتخاذ الخطوات العلمية المدروسة لتأمين
الحاجات المتزايدة على المياه وتلافي الأزمات المستقبلية التي تهدد المنطقة وسوريا
بشكل خاص.
2 ـ منهجية الدراسة:
2 ـ 1
ـ الواقع الراهن يقال دوماً أن سوريا بلد زراعي وليس لديها خيارات اقتصادية أخرى
في المستقبل المنظور، لذا كان تحقيق الأمن الغذائي أحد أهم أهداف السياسة المائية
ـ الزراعية في سوريا (3) وبعد أن التزمنا بهذه السياسة المائية منذ أن خطر على بال
الحكومة السورية سنة 1947 بانشاء سد يوسف باشا على الفرات. وخلال نصف قرن انجزت
الحكومة السورية الكثير في هذا المجال (كما انجزت اغلب دول العالم الكثير في هذا
المجال) (4) فلقد نفذ على نهر الفرات ثلاثة سدود لغايات الري وتوليد الطاقة وتنظيم
الجريان بتخزين يزيد على 14.190 مليار م3 ولري مساحة لا تقل عن 640000 هكتار؟ ولكن
نفذت عشر شبكات ري سطحي لري مساحة تصميمية قدرها 100493 والمساحة الفلية قدرها
96.026 ألف هكتار إذاً يلزمنا الكثير من الوقت والمال بعد!! كما نفذ اثني عشر سداً
على حوض نهر الخابور وسدين قيد التنفيذ بتخزين 1.33954 مليار م3 ولري مساحة
109.025 ألف هكتار ونفذت 14 شبكة ري لري مساحة تصميمية 29.260 ألف هكتار والمساحة
الفعلية 9.470 ألف هكتار. وفي قلب سوريا وعلى حوض العاصي نفذ 39 سداً لغايات توليد
الطاقة والري ودرء الفيضان وسقاية المواشي والشرب والترشيح لتغذية المياه الجوفية
وزادت طاقة التخزين أحياناً عن
708.689 م م3 لري مساحة تصميمية تقدر بـ 96.170 ألف هكتار ونفذت 22 شبكة ري لري
مساحة تصميمية قدرها 123.680 ألف هكتار والمساحة الفعلية 85.826 ألف هكتار. ونفذ
16 سداً في حوض الساحل لتخزين 472.21 م م3 لغايات الري والشرب والطاقة ولري مساحة
39.019 ألف هكتار ونفذت 21 شبكة ري لري مساحة تصميمية 49.699 ألف والمساحة المروية
3.890 ألف هكتار ونفذ 41 سداً في حوض اليرموك اضافة لسد الوحدة (قيد الانشاء مع
الاردن) ولغايات الشرب وسقاية المواشي وتربية الاسماك والري وتربية الابقار
وبتخزين 224.6 م م3 وتخزين سد الوحدة 225 م م3 ونفذت لري 13640 هكتار ولري وادي
اليرموك من سد الوحدة من قاع الوادي وحتى منسوب 200 فوق سطح البحر. ونفذت 35 شبكة
ري لري مساحة تصميمية 21226 هكتار والمساحة الفعلية 19089.5 هكتار ونفذ 37 سداً في
حوض البادية لتخزين 67.855 م م3 ولغايات الشرب وتربية المواشي والترشيح ودرء
الفيضان والري إن امكن ونفذت 3 شبكات ري لري 950 هكتار نظرياً. كما نفذ الكثير من
سدود التخزين على المسيلات بواسطة العمل الشعبي أو لدرء الفيضان عن الطرقات..
فمثلاً نفذ 7 سدود في ريف دمشق (والمدعو حوض دمشق أو حوض بردى والأعوج تجاوزاً)
لغايات درء الفيضان والترشيح لتغذية المياه الجوفية وسقاية المواشي والسياحة
لتخزين 8.282 م م3 كما انجز القطاع الخاص مشاريعه من خلال أكثر من مئة ألف بئر لضخ
المياه الجوفية واستعمال المياه للري والشرب وسقاية المواشي أو الصناعة إذا نفذت
الحكومة السورية أكثر من 157 سداً (مع سد الساجور وسد 17 نيسان على نهر عفرين...)
فروت فعلاً 214301.5 هكتاراً ولكنها خسرت أراضي خصبة لتخزين المياه تقدر بـ 67.4
هكتاراً لبحيرة الأسد فقط وتجفيف الخابور... والضائع بالتبخر من بحيرة الأسد مثلاً
1500 م م3 سنوياً مع أن القطاع الخاص يروي 4.5 مثلاً عن مشاريع الدولة وبأقل كلفة
وضياعات مياه أقل وبمردود أعلى علماً أن الدولة قد سهلت على نفسها بالاصلاح
الزراعي والتأميم والاعفاءات المختلفة واستملاك أراضي الغير بأسعار رمزية أن تدعي
الكثير من الإنجازات فأين مزارع وأقنية وتجهيزات مشاريع أصفر ونجار ومعماري باشي
وغيرهم والتي أصبحت من انجازات الدولة لاحقاً بما فيها خوض حروب لإنجاز سد اسوان
وسد الفرات؟
لذلك وكما قدم العالم من أفكار لاستصلاح الاراضي على الطريقة اللابريطانية (حيث
يدعو حزب الأحرار البريطاني لاصلاح زراعي من نوع آخر)(5). ومشاريع ري وتوليد طاقة
كهرمائية وغيرها بعد الحرب العالمية الثانية فإن العالم يتداول الأفضليات التالية
لاستعمال المياه بدلاً من الأفضليات القديمة وذلك لتحقيق أقل ضرر بالبيئة ولتحقيق
التنمية المستديمة (5).
2 ـ 2 ـ الأفضليات:
2 ـ 2 ـ 1 ـ الأفضلية الأولى لقطاع الاستعمالات
البلدية (الشرب) وتنقل المياه للتجمعات السكانية أو نشجع السكان على الانتقال
لمصادر المياه ضمن خطط التنمية المستقبلية (أيهما الأكثر اقتصاداً) فهذا القرن هو
قرن سيادة الاقتصاد على علوم السياسة أو علم المجتمع ولأول مرة ينتصر الاقتصاد على
السياسة عبر التاريخ الانساني.
2 ـ 2 ـ 2 ـ الأفضلية الثانية لقطاع الصناعة لأن
العائد المادي لاستعمال المياه بالصناعة يعادل 30 ضعفاً عن العائد من استعمال
المياه للري وعلى أن تستعمل المياه الناتجة عن الصناعة بعد المعالجة للري.
2 ـ 2 ـ 3 ـ الأفضلية الثالثة للسياحة والاصطياف
لأنها الأكثر ربحاً من استعمالها للري ونرى أن الأفضليات الثلاثة الأولى لا تؤدي
إلى نقص كبير في الكمية ولكنه تغير في نوعية المياه.
2 ـ 2 ـ 4 ـ الأفضلية الرابعة وهي استعمال المياه للري والحصول على الأمن الغذائي
المطلق أو النسبي، ثم تعطى.
2 ـ 2 ـ 5 ـ الأفضلية الخامسة للتشجير وتربية الاحياء
المائية في المياه التي لا تصلح للري.
2 ـ 3 ـ زيادة المصادر المائية: بزيادة حصة سورية من
الفرات ودجلة وفق قوانين المياه الدولية وتحويل فائض مياه حوض الساحل من المياه
السطحية أو الجوفية أو من التحلية لدعم حوض العاصي الأعلى وحوض دمشق واللجوء إلى
التقانة الرفيعة بقطف رطوبة الهواء او ترشيد الاستهلاك أو تقليل الضياعات في كافة
أنواع الشبكات المائية ورفع درجة تنظيم الأحواض السبعة المائية بسوريا ورفع درجة
كفاءة تشغيل وصيانة المشاريع المائية القائمة واستعمال تقنيات الزراعة والصناعة
الحديثة واللجوء إلى الهندسة الوراثية وتوليد الطاقة النووية أو المتجدة واستعمال
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الأمواج والمد والجزر وغيرها من التقانات
الحديثة لكي نصل إلى الكفاية النسبية ريثما تتراجع موجة تزايد السكان والتي قد
تتوازن خلال العقود القادمة من هذا القرن لأن نسبة تكاثر السكان قبل 20 سنة كبيرة
جداً ولكنها في العقدين الماضيين كانت بحدود 3.36% (3) وستنخفض مستقبلاً حسب قواعد
علم السكان ولكن في العقدين الأخيرين كانت نسبة تكاثر السكان أكبر من معدل نمو
الانتاج الزراعي والانتاج القومي بشكل عام.
2 ـ 4 ـ زيادة عدد السكان: إشارة للمجموعة الاحصائية لعام 1999 الصادرة عن
المكتب المركزي للاحصاء في سوريا وفي الصفحة 95 تشير إلى أن عام 1999 هو العام
الذي بدء فيه مخروط السكان بالاعتدال حيث يتبين أن نسبة المواليد وشريحة الاطفال
الأقل من 5 سنوات أقل عدداً من شريحة الاطفال بعمر 5 إلى 10 سنوات وبالعودة إلى
احصائيات 1960 و 1980 و 2000 نجد أن عدد السكان قد تزايد من 4.565 إلى 8.800 إلى
16.5 مليون نسمة (6) ويمكن القول أن التزايد المتسارع قد انتهى مع عام 1999 وبدء
التزايد المنتظم والذي يمكن تقديره بـ 2% سنوياً حتى سنة 2020 ثم يبدء التزايد
المتباطئ حتى منتصف القرن ويستقر عدد السكان. إذاً يمكن توقع عدد السكان سنة 2020
حوالي 25 مليون نسمة وسنة 2050 حوالي 32 مليون نسمة وهو الحد الأقصى للسكان
المتوقع وهو ضعف عدد السكان لسنة 1999 وذلك لأسباب تتعلق بتحرر المرأة والرجل
وشيوع العلم والمعرفة ومحدودية المصادر الطبيعية في سورية إلا إذا تتدخل العلم
وتقدمت التقانة وقدمت الانتاج الوفير من هذه المصادر المحدودة ولا أظن أن ذلك يسهل
التنبؤ به ومعرفته ولكن في حدود المعرفة لعلم السكان وتطور الموارد الطبيعية فهل
يمكن أن يتضاعف عدد سكان سورية وتتضاعف مواردنا الطبيعية وخاصة الموارد المائية؟
3 ـ الوضع الراهن للموارد المائية في سوريا:
يتضمن الجدول (1) الانتاج الفعلي من المواد
الغذائية الرئيسية في سوريا، بينما يتضمن الجدول (2) الاحتياج إلى المواد الغذائية مع تزايد عدد السكان 1999 و 2000 و 2010 و 2020
و 2030 و 2040 و 2050 ويتضمن هذا الجدول للمواد الغذائية وللمحاصيل الصناعية
(التي تؤمن القطع الأجنبي لشراء مستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي وبقية المتطلبات
الخرى) ولتحقيق هذا الجدول فيجب استثمار الموارد المائية والأراضي المتاحة في
سوريا بنوعيها البعلية والمروية (3).
تقسم سوريا إلى خمس مناطق استقرار زراعية (6) و (3).
حسب الجدول (3). والذي يبين أن 1.76 مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي يزيد فيها وسطي
الهطول المطري عن 600 مم/السنة وإذا زرع ثلثي هذه المساحة بالحبوب (3) وكان عطاء
الهكتار اكثر من 3 طن وهو الحد الأدنى فيكون الانتاج السنوي الكامن لهذه المنطقة
3.6 مليون طن ويتوفر 2.67 مليون هكتار ذات هطول مطري بين 250 ـ 600 مم/السنة
وإذا زرع ثلثي هذه المساحة بالحبوب (3) نجد أن الانتاج السنوي الكامن لهذه المنطقة
2.7 مليون طن (حيث عطاء الهكتار لا يقل عن 1.5 طن كحد أدنى). وهذا يعني أن تحسين
استثمار الأراضي البعلية باستعمال الآلات الزراعية والأسمدة والمبيدات المناسبة
والري التكميلي سينتج ما تحتاجه سورية حتى عام 2000 تقريباً مع انتاج الخضراوات
والفواكهة والاعلاف اللازمة لتربية الحيوان لانتاج جزء من الاحتياجات إلى اللحوم
والحليب والبيض... (3) وإذا طرحنا الانتاج الكامن في الأراضي البعلية من الاحتياج
الأدنى للمواد الغذائية الرئيسية والمحاصيل الصناعية الضرورية نحصل على الانتاج
الواجب تحقيقه بواسطة مشاريع الري حتى 2050 كما هو مبين في الجدول رقم /4/ وهذا يدل على أهمية انتاج الأراضي البعلية ولا يعني عدم زراعة الحبوب في الأراضي
المروية في السنوات الجافة أو نصف الجافة.
في الجدول /5/ تقدير للمساحات الواجب استصلاحها وريها وبالتالي تقدير كميات المياه التي
تحتاجها هذه المساحات. علماً أن الأراضي المروية التي ستزرع بالحبوب لم تدخل
مساحاتها في الجدول رقم /5/ لأنه يمكن زراعة الحبوب كمحاصيل متأخرة انتقالية
بين محصول وآخر واعتبر أن انتاج الهكتار المروي من الحبوب لا يقل عن 3 طن (بينما
ينطبق هذا الرقم بشكل خاص على القمح ولكن يمكن زيادة انتاج القمح حتى 5 طن/هـ
وأكثر).
وكما هو الانتاج الكامن في الأراضي البعلية من اللحوم
والألبان والبيض والخضار والفواكهة هو نتيجة دراسات حقلية بحس هندسي كذلك فالمساحة
الواجب ريها للأعلاف لإنتاج اللحوم والالبان وغيره هي مساحة افتراضية تقدر بـ 0.7
ـ 0.8 طن من اللحوم لكل هكتار مزروع بالاعلاف... بينما ينتج الهكتار المزروع
بالخضار بين 19 إلى 20 طن وسطياً ولكن الهكتار المزروع بالفواكهة ينتج حوالي 12 طن
وسطياً منها.. ويعطي الهكتار وسطياً من المحاصيل الصناعية حوالي 10 طن
وسطياً...(3).
وبافتراض أن المقنن المائي 10500 م3/هـ بالسنة حسب دراسات وزارة الري ونصف هذه
القيمة في دراسات وزارة الزراعة (7)؟ وكذلك تفترض وزارة الري أن المياه الراجعة من
المساحات المروية ستغطي من حيث الكم (وبغض النظر عن النوعية) لاحتياجات المياه في
الاستعمالات المنزلية والصناعية بينما المياه الراشحة للحوض الجوفي حسب دراسات
وزارة الزراعة لا تقل عن 40 ـ 42% (أي أكثر من 10% التي تفترضها وزارة الري في
الأحواض المائية السورية لمياه صرف زراعي ونحو 15% في حوض الفرات بشكل خاص) أو أن
المياه اللازمة لوزارة الزراعة = 1/3 كمية المياه الكلية اللازمة لوزارة الري ولكن
الهكتار يمكن أن يعطي 5 طن من الحبوب باستعمال التقانة التقليدية فقط ومع
استعمالها لتسمين العجول فيصبح كل 5 كغ من الاعلاف تعطي كغ من اللحم بدلاً عن 39
كغ حسب الطرق القديمة... ويصبح الهكتار يعطي 6 طن من اللحوم ويمكن مضاعفة انتاج
الخضار والفواكهة كذلك إلى 40 طن للهكتار من الخضار و 25 طن من الفواكهة... وإلى
20 طن من المحاصيل الصناعية للهكتار...
ومع استعمال أوليات هندسة الوراثة فيتضاعف الانتاج
ضعف واحد على الأقل وقد يصل إلى مضاعفات خيالية رهناً بالمستقبل القريب...
و الجدول /6/ يبين المساحات الواجب استصلاحها
وريها لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي النسبي واجمالي الاحتياجات المائية حسب وزارتي
الري والزراعة باستعمال التقانة التقليدية واستعمال بدايات الهندسة الوراثية.
إذاً يلزمنا حسب خطط وزارة الري أكثر من 51 كم3 من المياه
الاضافية للوضع الراهن لري مساحات جديدة قدرها 4874000 هكتار فما هي المياه
المستعملة حالياً وما هي المساحات المروية فعلاً وهل تتوفر المياه الاضافية
والأراضي الجديدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي أو المطلق وما هو الأمان الممكن
تحقيقه؟
يبين الجدول /7/ الموازنة المائية في سوريا في نهاية عام 1995 (3) متضمنة الواردات المائية
السطحية والجوفية واستعمالات المياه في الأحواض المائية السبعة من مجمل المياه
المتاحة للاستخدام وذلك لتقدير الرصيد الوطني المائي في كل حوض وبالتالي في سوريا
في نهاية عام 1995 حيث استخدمت سوريا 13.728 كم3 من أصل إجمالي المتاح للاستخدام
18.818 كم3 وفاض عن استخدامها (الرصيد) 5.090 كم3 وفائض حوض الساحل كبير نسبياً
(أو أن درجة تنظيم الموارد المائية في حوض الساحل متدنية) وذلك بسبب الظروف الجيولوجية
والهيدروجيولوجية الصعبة لموقعه على طرف الانهدام العربي ـ الافريقي ولتميزه
بالفوالق الرئيسية والثانوية وبالتشكيلات الكارستية والشديدة التشقق مما يجعل
بناء سدود تخزينية فيه (لتخزين فائض المياه) وتحويلها لحوض العاصي الأعلى الذي
يعاني عجزاً متزايداً أمراً مكلفاً علماً أن مواقع السدود التخزينية في الساحل
ستغمر أراضي صالحة للزراعة وتتطلب تقنيات عالية واستثمارات مالية باهظة مع أنه
سيستخدم 640 م م3 من مياه حوض الساحل في مشاريع قيد التنفيذ أو الدراسة حالياً؟
وفائض حوض الفرات والخابور ودجلة هو الأهم رغم بروتوكول 1987 مع تركيا والاتفاق
السوري ـ العراقي لعام 1989 والذي أتاح لسوريا من مياه الفرات 210 م3/ثا من أصل
995 م3/ثا (وسطي التصريف الطبيعي لنهر الفرات) أو 6.627 كم3 بالسنة من أصل 31.4
كم3 الداخلة على الحدود السورية التركية من مياه الفرات وإذا أضفنا لحصة سوريا
المؤقتة 1.3 كم3/السنة (الواردات المائية الجوفية لحوض الفرات) و 0.649 كم3/السنة
موارد مائية لحوض حلب الملحق بحوض الفرات فأصبح واردات الحوض 8.576 كم3/السنة
والفائض 3.181 كم3/السنة، (في سنة 2000) حيث ستصبح المساحات المروية 1.491 مليون
هكتار وتستهلك 15.655 كم3/السنة (حسب فرضيات وزارة الري) والاستخدامات المنزلية
ستصبح:

أي سيزداد الراجع بمقدار 137 م م3 ورواجع الصرف
الزراعي سيزداد من 1272 م م3 سنة 1995 إلى 1600 م م3 تقريباً والزيادة تقدر بـ 328
م م3/السنة وبالتالي اجمالي المتاح للاستخدام من المياه سنة 2000 (حسب فرضيات
وزارة الري) 19.283 كم3/السنة والمطلوب 15.655 + 1.109 + 0.350 كم3 للصناعة +
1.738 فوائد التبخر وهي ثابتة تقريباً؟ = 18.852 والفائض = 0.431 كم3/السنة
وبالتالي سنة 2001 هي سنة التوازن المائي علماً أن وزارة الري تقدر أن سنة 2000 هي
سنة التوازن المائي (3) وآخرين قدروا سنة 2035 ـ 2037 كسنة للتوزان المائي (8) حيث
طور مفاهيم وزارة الري لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي النسبي أو بعضها وهي كمايلي
(3).
3 ـ 1 ـ زيادة حصة سوريا من مياه الفرات بصورة عادلة
ومعقولة وفق احكام قانون المياه الدولي حيث تقسم مياه الفرات بنسبة الثلث لتركيا
والثلثين لسوريا والعراق (لسوريا 42% وللعراق 58%) وبذلك تصبح حصة تركيا 10.47 كم3
من أصل 31.4 كم3 (أي الثلث) وحصة سوريا 8.79 كم3 (28% من مياه النهر) وبذلك تروي تركيا
587 ألف هكتار (68% من المخطط له) و 445 ألف هكتار في سوريا (60% من المخطط له)
ونحو مليون هكتار في العراق (56% من المخطط له) وتوليد 1.8 مليار كيلو واط ساعي من
الطاقة بسد الطبقة (67% من المخطط له) وهذا يعني زيادة حصة سوريا بزيادة 2.163
كم3/السنة لتضاف للموارد المائية المبينة في الجدول (7).
3 ـ 2 ـ حصول سوريا على حصة عادلة ومعقولة من مياه
نهر دجلة وفق الأسس نفسها ولما كان تصريف دجلة على الحدود السورية التركية 586
م3/ثا أو 18.5 كم3 بالسنة وحصة سوريا من مياه النهر (دون الدخول بالتفاصيل) 5 كم3
بالسنة لري 372 ألف هكتار حسبما اعلمت سوريا الأطراف الثلاثة في اللجنة الفنية سنة
1983 علماً أن سوريا قد انهت المخططات لري مساحة 150 ألف هكتار بمياه نهر دجلة
كخطوة أولى في هذا المجال. واستراتيجية المياه في سوريا تستدعي أن تكون المبادرة
من سوريا فتركيا دولة المنبع والعراق هو المستفيد الأكبر من مياه دجلة (عبر مشروع
الثرثار وغيره) والمتضرر الوحيد من عدم الوصول إلى اتفاق نهائي على قسمة النهرين
تقريباً هي سورية. ولذلك يجب رفع مستوى الاجتماعات في اللجان الفنية المشتركة إلى
أعلى مستوى ممكن (ضمناً مستوى الرؤساء) والتوجه إلى الدول العربية الشقيقة لربط
علاقة الدول العربية مع تركيا بموقف تركيا من موضوع مياه دجلة والفرات حتى يتم
الاتفاق الثلاثي النهائي بالاستناد إلى أحكام قانون المياه الدولي وحسن الجوار
واتباع سياسة الدولة الأجدر بالرعاية بين الأطراف الثلاثة. والتوجه إلى الدول
الأوربية وشركاتها ومؤسسات الاقتراض الأوربية بأن تتبع سياسة البنك الدولي بعدم
تمويل المشاريع على الانهار الدولية إلا بعد اتفاق الأطراف المعنية. وتركيز
التنسيق السوري ـ العراقي لاعادة النظر بمبدأ (الفرات أولاً) ليصبح باتجاه (الفرات
ودجلة معاً) والقائم على حسن الجوار وسياسة الدولة الأجدر بالرعايا بين الأطراف
المعنية واعادة طرح انشاء سد مشترك على نهر دجلة لصالح الأطراف الثلاثة (ويقع على
الحدود السورية التركية أو السورية العراقية).
والتفكير جدياً بقسمة مياه نهر دجلة بين سوريا
والعراق كما اتفق على قسمة مياه نهر الفرات تسهيلاً للاتفاق الثلاثي (علماً أن
الجانب العراقي قد وافق من حيث المبدء على ذلك في انقره سنة 1990 ـ حزيران) واعادة
النظر في استراتيجية مشاريع الري السورية في حوض الفرات (افقياً وشاقولياً) وفق
الحصة المتوقعة من مياه الفرات والمباشرة فور الاتفاق على قسمة مياه دجلة بتنفيذ
مشاريع الري السوري على دجلة وتفهم أن نوعية مياه الفرات ودجلة ستتناقص نوعيتها
وفق المساحات المروية في تركيا لأن مياه الصرف الراجعة أقل جودة لاحتوائها على
الأسمدة والاملاح والمبيدات...
ومحاولة ربط نوعية المياه بالحصص المائية فكلما ساءت
النوعية تزداد حصة الحبس السفلي، والمثابرة على ترشيد استخدام المياه بحيث يمكن
استرداد رأس المال الموظف في مشاريع الري وبالتالي تتلخص استراتيجية وزارة الري
(3) بأنه إذا حصلت سوريا على حصتها من مياه دجلة ونقل 0.5 كم3 من مياه الساحل
للداخل فسيكون عام 2008 عام التوازن المائي وعندئذ ستروي (المقنن المائي محملاً
عليه الاستهلاكات البلدية بحدود 5500 م3/هكتار بالسنة)، 4.5 مليون هكتار وهذا يعني
استثمار سقف الموارد المائية والمقدر بـ 26 كم3 بالسنة مع تنظيم بنسبة 90% ومع
ترشيد الاستهلاك إلى نصف وضعه الحالي.
3 ـ 3 ـ باقي المياه الدولية المشتركة وهي الأقل أهمية بعد الفرات ودجلة فمياه نهر
الآردن وروافده قليلة والتنافس عليها شديد بين الاطراف الخمسة ـ لبنان وسوريا
والاردن وفلسطين واسرائيل ـ وهذه المياه ستشكل عنصراً هاماً من عناصر السلام تبعاً
لاحكام القانون الدولي والشرعية الدولية وسوريا مع الاردن وتبعاً لاتفاقية 1987
بصدد تشييد سد الوحدة (سد المقارن سابقاً) والاردن مع اسرائيل تبعاً لاتفاقية وادي
عربة لسنة 1993 قد اتفقوا على مياه نهري اليرموك والاردن الأسفل ويبقى التحدي
الاستراتيجي للعالم أجمع بأن تقبل اسرائيل بالقانون الدولي (وتطبيق مبدأ الارض
مقابل السلام) وأما الجولان الذي يقع كحوض صباب لنهر الاردن الاعلى فأهله بحاجة
إلى مياه من نهر الاردن الاعلى وروافده حاضراً ومستقبلاً وعلى اسرائيل إن رغبت
بالسلام أن تقنع بمواردها المائية الداخلية وحصتها العادلة والمعقولة من المياه
الدولية المشتركة مع جيرانها والمياه ليست عائقاً لاسرائيل لأنها تملك الطاقة
النووية وتقانات تحلية مياه البحر وتقانات مكافحة التصحر بينما لا يملك جيرانها في
الحوض مثل هذه التقانات ولربما تنقلب عملية السلام خيراً على العرب في النهاية
(9). (انظر التفاصيل في المثال المرفق بهذه الدراسة). ومياه نهر العاصي الذي يدخل
سوريا من لبنان بتصريف 16.16 م3/ثا (510 م م3/السنة) ويصب على البحر الابيض
المتوسط بتصريف 28.2 م3/ثا (890 م م3/السنة) وهو النهر الأكثر أهمية لأنه يخترق
سوريا في وسطها وشمالها وغربها، ويعاني العاصي من نقص في المياه بسنوات الشح مما
يؤدي لتقليص المقننات المائية أو المساحات المروية لتأمين المياه لشرب حمص وحماة
ولصناعات المنطقة الوسطى بسوريا وسيزداد عجزه في السنوات القادمة مع تزايد السكان
واحتياجاتهم ولذلك اقترح تحويل فائض مياه حوض الساحل لرفد حوض العاصي الاعلى
بحوالي 0.5 كم3 سنوياً. والعاصي كنهر دولي يخضع لإتفاقية سورية لبنانية سنة 1994
حيث قدرت مياهه الوسطية السنوية عند جسر الهرمل بـ 403 م م3/السنة وحددت حصة لبنان
بـ 80م م3 وحصة سوريا بـ 323 م م3/السنة اضافة لـ 35 م م3/السنة وهي جريانات تضاف
للنهر بين جسر الهرمل والحدود السورية اللبنانية ولما كانت تركيا قد قبلت هدية
فرنسا سنة 1936 واستلمت لواء اسكندرون (هاتاي) رغم أن فرنسا لا تملك الصلاحية
القانونية كسلطة انتداب على سوريا آنذاك وحتى لا يتعطل أي اتفاق على قسمة نهري
الفرات ودجلة فيجب أن نعترف لسكان اللواء بحصة عادلة ومعقولة من مياه نهر العاصي
دون أن نعترف بعائدية أراضي اللواء لتركيا. وعندما يعود اللواء سيعود بأرضه ومائه
إلى الوطن الأم (3) وهذه الصيغة ملائمة لنهر قويق وغيره من الانهار والتي قطعتها
تركيا عن سوريا بحفر آبار عميقة لتجفيف ينابيع الانهار في الأراضي السورية
(البليخ، بعض روافد الخابور...).
ومياه نهر الكبير الجنوبي الذي ينبع من سوريا ولبنان ويشكل الحدود الدولية
بينهما بطول 56 كم ويصب على البحر الابيض المتوسط بتصريف 7.95 م3/ثا (251 م م3
بالسنة) وتجري الان مشاورات بين سوريا ولبنان لاقتسام مياه النهر وبناء سد مشترك
لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية لصالحهما.
4 ـ
الوضع المستقبلي للموارد المائية السورية (استراتيجية وزارة الري السورية) (3)
اعدت وزارة الري في العقدين الأخيرين دراسات عديدة (3 ـ 8 ـ ..) فاقترحت
العديد من الاجراءات كالتالية:
4 ـ 1 ـ اعادة توزيع المياه بين مختلف الاحتياجات واعادة الأفضلية الأولى
لمياه الشرب ومعالجة المياه الراجعة من الاستعمالات البلدية (المنزلية
والصناعية...) لكي تصبح المياه صالحة لاستعمالات الري، وأفضلية استعمال المياه
للصناعة عن الري لأن انتاجية م3 من المياه في الصناعة تزيد عن ثلاثين ضعفاً (3)
لانتاجيتها في الزراعة وأن أول المتضررين من هذه السياسة هي المحاصيل الصناعية مما
سيؤثر سلباً على الميزان التجاري السوري (3) وسوريا تنفذ هذه السياسة الاستراتيجية
ففي سنوات الشح يعاد توزيع المياه بين الشرب والزراعة في حوض اليرموك (ينابيع
المزيريب) وحوض دمشق والعاصي الاعلى ومنطقة ادلب (سهل الروج).
4 ـ 2 ـ التطلع لاستعمال التقانات التقليدية وغير التقليدية وذلك من خلال
اعادة النظر بالدورات الزراعية المعتمدة والاستفادة من البذور المحسنة ومن منجزات
علم الهندسة الوراثية وطرق المكافحة البيولوجية لانتاج المزيد من الغذاء بأقل كمية
مياه ممكنة وعلى أصغر مساحة مروية وكذا اللجوء إلى المكننة أو الأسمدة... واعادة
النظر في طرق الري المطبقة حالياً والاتجاه نحو الري بالرش أو التنقيط حيثما برر
ذلك فنياً واقتصادياً (وجهة نظر مشتركة بين وزارتي الري والزراعة) واعادة النظر في
درجة تنظيم الموارد المائية وزيادتها حيثما برر ذلك فنياً واقتصادياً..
4 ـ 3 ـ التحضر بمتابعة ترشيد استخدام المياه بالتوعية خلال مراحل التعليم
وخلال وسائل الاعلام وعن طريق تسعير المياه على شرائح... وضبط استخداماتها
باستعمال عدادات مناسبة لاسترداد رأس المال الموظف في مشاريع الري قدر الامكان.
والحد من هدر المياه وسرقتها وتطبيق التشريع المائي والقانون على الجميع دون
استثناء.
4 ـ 4 ـ التحديث لشبكات مياه الشرب والري القديمة لتقليل الهدر والضياع
الذي يصل إلى 60% احياناً وتنفيذ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي للتجمعات
السكانية ومحطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالحدود الاقتصادية. واللجوء إلى
المطر الصناعي والتأثير على الظروف المناخية للحصول على المزيد من المياه وتحلية
المياه بالطاقة النووية...
4 ـ 5 ـ تطوير البحث العلمي للواقع السوري بما فيه استعمال مياه البحر في
انتاج الغذاء.
4 ـ 6 ـ التعاون الاقليمي لنقل المياه من الانهار التركية التي تصب في
البحر المتوسط أو الأسود إلى حوضي الفرات ودجلة أو العاصي... وهذا سيغير وجه
المنطقة فتحويل شط العرب سيروي بادية الشام ومنطقة الخليج أو أكثر من ذلك (10).
4 ـ 7 ـ تحرير المرأة لتقليص نسبة تكاثر السكان وخلق فرص عمل جديدة والحد
من البطالة السافرة أو المقنعة ورفع سوية التعليم والرعاية الصحية والمستوى
المعاشي...
4 ـ 8 ـ رفع أداء القانون الدولي للمياه والذي يمكن تلخيصه بمبدئين هما:
الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان بمياه المجرى المائي الدولي وعدم جواز
إلحاق ضرر ذي شأن بدول المجرى المائي بالحبس السفلي عن طريق التعاون والتفاوض وحسب
القاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
5 ـ المرابح من بناء استراتيجية مائية في سوريا:
5 ـ 1 ـ حوض الفرات ودجلة (نهري
الفرات ودجلة لامداد المياه السطحية والجوفية على المستقبل المنظور) تبين الاقمار
الصنعية (11) أهمية نهري الفرات ودجلة على امداد المياه السطحية لتركيا وسوريا
والعراق ولاحقاً كمصدر محتمل لتغذية المنطقة المعنية سطحياً وجوفياً حسب مخطط
استراتيجية المياه المقترح لهذه الدارسة والجدول /8/ يبين المياه السطحية السنوية الوسطية الكلية المقدرة للاقطار الثلاثة سوريا
وتركيا والعراق والنسبة التقريبية للجريان الوسطي الكلي من الفرات ودجلة.
من الصعب محبة الجار الذي يعيش على الحبس العلوي للنهر لأنه يتحكم بكمية
ونوعية المياه التي تصل إلى الحبس السفلي وهذا جوهر المشكلة لنهري الفرات ودجلة
(والعاصي واليرموك) وفي كافة انحاء العالم المشابه... فهي قضية عالية التعقيد
ويمكن أن تصبح دموية [فعندما قطع سد الثورة (الطبقة) جريان الفرات عن الحبس السفلي
في العراق بنسبة 25% سنة 1974 ـ 1975 فأصبح وضع ثلاثة ملايين عراقي بخطر عندئذ،
أرسلت العراق جيشها إلى الحدود السورية]. وفي تركيا مشروع الاناضول العظيم Grand
Anatolia Project متضمناً انشاء 22 سداً على النهرين ومن بينها سد أتوتورك الضخم
على الفرات والذي أصبح خامس سد مبني بالحجر في العالم rock - Filled dam واعترض
العراق على هذا المشروع بالقول [أن حصته ستنقص من الفرات من 30 كم3 سنوياً إلى أقل
من الاحتياجات الدنيا وسيقطع حوالي 50% من تصريف النهر بسوريا والبالغ 31.8 كم3
سنوياً بينما أغلب المياه المتبقية مالحة نتيجة للري التركي]، بينما تدعي تركيا
انها تنظم الجريان حتى خلال موسم الجفاف، بينما قطع الفرات كلياً لمدة شهر سنة
1990 وجف الامداد في الحبس السفلي بشكل كلي غالباً. مثل هذه السلطة على مصدر حيوي
هي سلطة خطرة في مثل البيئة السياسية الحرجة أو الهشة وبسهولة نسبياً يمكن أن تبدء
الحرب وهي جوهر مشاكل الشرق الأوسط بأن للسلطة معايير مزدوجة واضحة. فكل سلطة
تمارس حقها على الحبس العلوي بأنها تملك كل الحق بهذا المصدر وتشتكي بنفس الوقت
عندما تقع على الحبس السفلي في مكان آخر؟ وحرب الخليج سنة 1991 قد جعلت الوضع أكثر
تعقيداً فحرق حقول النفط الكويتي قد هدد طبقة المياه الجوفية في العراق. وهذا التهديد
جعل المتطلبات العراقية من مياه الفرات ودجلة أكثر استعجالاً more urgent كما أن
المخططات التركية لتطوير المنطقة الجنوبية الشرقية SAP ذات 22 سداً و 19 محطة طاقة
بكلفة قدرت بـ 35 مليار دولار تهدف لنقل أقليم الجنوب الشرقي لتركيا من الفقر إلى
القوة والغنى ولكن الصراع المستمر مع الاكراد الانفصاليين في الجنوب الشرقي مع رفض
مزمن بالاعتراف بهم وأنهم أتراك الجبل؟ ومنذ عام 1984 وفدائي حزب العمال الكردي
(P.K.K) Kurdish Worker's Party ذو التوجهات الاشتراكية غالباً، يخوضون حرباً
دموية لتحقيق سلطة اقليمية أولاً ويشاركهم الاكراد الآخرين بالعراق وايران وسوريا
لتشكيل دولة مستقلة. وإن تحققت هذه الدولة ولريثما يميل الاكراد للواقعية ويتركون
المثالية التي تترافق مع الاستقلال فإن منطقة الفرات ودجلة هي منطقة صراع مستقبلي
بين الاكراد والاتراك والسوريين (وإلى درجة ما) العراقيين والايرانيين، لذلك يحتاج
حوض هذا النهر لربط المياه بمعاهدات بين اطراف متعددة وذلك يستدعي استقراراً
سياسياً وإلا فستخوض الجيوش صراعاً بمقياس كبير حول المياه... خاصة وإن اسرائيل قد
تسللت إلى مسرح الصراع أيضاً؟
5 ـ 2 ـ المرابح: إذاً فالتنافس حول المياه يمكن أن يقود إلى الصراع فما
زال حول الانهار أو المسيلات المتقطعة الجريان أو الأحواض المائية الجوفية لحوض
الفرات ـ دجلة مثلاً، نقصاً في الحقوق والواجبات لأطراف مشاركة حول المصدر المائي
نفسه، وهذا الغياب الكلي لأي نوع من التنظيم المتفق عليه رضائياً من كافة الاطراف
(إلى أبعد حد ممكن) يستوجب الحل فما زال ينظر لمسألة المياه على أنها مصدر محلي
ويجب أن تدافع عن هذا المصدر بأية كلفة ممكنة بينما تعالج المشكلة بالنظر للمياه
كمصدر عالمي وليس كمصدر وطني أو محلي... سيؤدي التنافس على المياه في الشرق الاوسط
إلى زيادة التوتر السياسي ولتخريب البيئة الحقيقية لكافة المصادر والتي تكافح
الأمم من أجل الحفاظ عليها. فمثلاً يحتوي حوض البادية السورية على حويضات منها
حويضة الدو حول تدمر ذات المليارات المحدودة من الامتار المكعبة فإذا استنزفت
لمعمل الفوسفات المقترح في الشرقية فإما يجب تدوير المياه المستعملة والتي ستتناقص
حتى تنفذ وبالتالي يجب تعويض الفاقد من نهر الفرات مثلاً أو عدم تصنيع أو تنمية
المنطقة إلا بالقدر الممكن والذي يدعى بالتنمية المستديمة. وكذلك فتوازن المياه
حرج وخطر في السعودية وغيرها من البوادي بحيث يجب التفكير باعادة استعمال المياه
لأغراض بدلاً من ري القمح مثلاً فالضخ المتزايد من الآبار مع التخاصم السياسي The
Political Wrangling فوق حوض الاردن (اليرموك) ومخططات التحويل وما تبعها من ردود
فعل من الأطراف الأخرى المختلفة كانت مؤذية جداً ومرتبطة بتقطيع أواصر الابناء
نتيجة لصراع الآباء The limb from limb rendering an infant by irreconcilable and
importunate parents إذاً تناقض وتضارب مصالح الآباء المزعج قاد لحروب 1967 و 1973
و ....
فسوء الادارة قد بدل التداخلات التقليدية واغلب التوافقات بين البيئة
الانسانية والفيزيائية. وغالباً فالعجز الكلي عن احترام الطبيعة سيدمر مستقبل
الاجيال القادمة والتي تعتمد على المصادر الطبيعية للارض. ومع ذلك ففي الشرق
الاوسط تقرر السياسة كافة التوظيفات للمصادر ومواقعها وتوزيعها وبذلك خلقت
الحكومات عدم المساواة وأصبح وضع المياه ميئوساً منه (بائساً) حتى الآن في الشرق الاوسط
وطبقت قاعدة water is power is politics الماء هو سلطة وهو سياسة. فمثلاً تأخذ
اسرائيل ما يكفيها بالقوة وتترك للفلسطيني أو الاردني أو السوري الحثالات وهذه
التوجهات ستؤدي حتماً لتدهور مصادر المستقبل وعدم المساواة وبالتالي عدم الاستقرار
السياسي وهذا يؤدي للعنف أساساً. وهذه الدائرة المفرغة تهدد ملايين في الشرق
الاوسط وغيرهم في اماكن أخرى أيضاً فسوء استعمال البيئة مدمر وصحة المصادر اساس
لكافة أنواع الحياة فلا يوجد اساس لإدارة مجتمع ناجح إلا إذا تغير سوء الاستعمال
وهو ما يهدف إليه بناء استراتيجية مائية في سوريا كما يهدف إلى:
1 ـ تبادل المعلومات والمعرفة وتدعيمهما بين المعنيين في الاقطار المعنية
وذلك من خلال الندوات وورشات العمل واللجان المشتركة والقيام بالدراسات واجراء
المشاريع المشتركة في نهاية المطاف.
2 ـ مراجعة شاملة للشروط الهيدرولوجية وطرق القياس وذلك من خلال استعمال
تقنيات الأثر water tracing مثلاً أو الاستشعار عن بعد أو الاستنتاج من المعلومات
المتاحة الجيولوجية والجيوفيزيائية أو القيام بهذه الدراسات لاستكمال المعلومات عن
الاحواض المائية الجوفية وجرياناتها وسرعاتها وسعتها...
3 ـ تبني التقنيات العالمية لاعمال الدراسات والتنفيذ ونقلها مع التطوير
إلى منطقة مشروع الشرق الاوسط تبعاً لاستراتيجية المياه السورية لكي يمكن الاعتماد
على الذات لاحقاً من قبل الجهات المعنية في الاقطار المعنية.
4 ـ دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية واقتراح السبل لتحسين هذه الاوضاع
من خلال برامج تنموية قادرة على دفع الحالة الاقتصادية ودفع المستوى الاجتماعي
خلال فترات معينة.
5 ـ الاستقرار السياسي والناجم عن تفهم الاحتياجات المتبادلة داخلياً
وخارجياً لكل تجمع سكاني والسعي لدى الجهات الدولية لتمويل برامج طموحة تهدف لخلق
حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والذي يقود إلى الاستقرار
السياسي لاحقاً.
6 ـ حماية البيئة وذلك من خلال حماية الحياة النباتية والحيوانية الهشة
وحماية المصادر المائية ومكافحة تلوث الهواء أو التربة أو المياه السطحية والجوفية
قدر الامكان. ودراسة التجهيزات لمراقبة البيئة الهوائية والمائية والتربة ودراسة
كافة الملوثات والانذار عند اللزوم مع رفع مستوى الوعي البيئي بين القاطنين
ومتابعة برامج التنمية المستديمة وحماية البيئة معاً.
7 ـ استعمال التقنيات الحديثة في مجال تحلية المياه الجوفية المتزايدة
الملوحة في المناطق الصحراوية أو باستعمال المياه للري عدة مرات في الشرق الاوسط
بشكل عام مع التركيز على استعمال الطاقة النظيفة لتقليل الكلفة؟ الطاقة الشمسية ـ
طاقة الرياح ـ طاقة الاعماق الجوفية ـ طاقة المد والجذر ـ الطاقة الحيوية... أو
الاعتماد على الطرق الحيوية للتخلص من شوارد الاملاح لطبقات المياه الجوفية أو
المياه بشكل عام مع استعمال كافة التقانات التقليدية وغير التقليدية كالهندسة
الوراثية وهندسة المعلومات... هندسة المواد الجديدة وقطف رطوبة الجو...
6 ـ معلومات لبناء استراتيجية مائية سورية (12)
يتساقط على المشرق العربي (سوريا ـ العراق ـ فلطسين ـ لبنان ـ الاردن) 174
كم3 من الامطار حيث تشكل الامطار غير المفيدة والتي تتساقط في بادية الشام كمية
قليلة من المياه حسب الجدول (9) حيث
يتبخر جزء من الامطار ويترشح قسماً منها داخل الارض ويسيل قسماً على سطح الارض
حيث متوسط هطول الامطار في المشرق العربي كما في الجدول (10) واشهر انهار المشرق العربي حسب الجدول (11) علماً أن اقليم دجلة والفرات لا تزيد فيه ملوحة المياه الجوفية عن 1000 جزء
بالمليون بينما احواض المشرق العربي لا تزيد ملوحة مياهها الجوفية عن 500 جزء
بالمليون. والخزين المتجدد والاستراتيجي للمياه كما في الجدول (12). والموارد المائية المستغلة في المشرق العربي م م3 في الجدول (13) و الجدول (14) يبين
استغلال الأراضي للأغراض الزراعية في المشرق العربي. فلا يزال أراضي زراعية يمكن
استغلالها ولكن احتياجات المياه أكثر مما هو متوفر فعلاً فاحتياجات المشرق العربي
81.7 كم3 للزراعة و 5.6 كم3 للصناعة و 7.1 كم3 للاستعمالات المدنية (البلدية)
والمجموع 94.4 كم3 بالسنة لعام 2000 لذلك لابد من استراتيجية اعادة استعمال أكثر
من مرة لكي تتوافق المصادر مع الاحتياجات أو استعمال التقانات التقليدية وغير
التقليدية علماً أن الحصة المائية للفرد الواحد في الوطن العربي عام 1960 هي
3430 م3 بالسنة وستنخفض إلى 667 م3 بالسنة سنة 2050 (5) بينما هي حالياً 107
م3 في الكويت و 148 م3 في السعودية و 1120 م3 في مصر و 368 م3 في الاردن حيث
توزع الحصص المائية في المشرق العربي تبعاً للجدول /15/ وأن الأراضي المروية تنتج ضعف الانتاج الوسطي و90% من الوسطي (إذا كانت الامطار
السنوية ( 300 مم) و 60% (إذا كانت الامطار السنوية ( 300 مم) ولكن مازال باستعمال
التسميد المناسب لوحده أن يتضاعف انتاج الحبوب كالقمح من 4 طن/هكتار حتى 8 طن/هكتار
وباستعمال البذور المحسنة وغيرها فيمكن توفير المياه ومضاعفة الانتاج... علماً
أن الضغط السكاني كان عام 1974 بمعدل 1.3 سكان للهكتار وأصبح سنة 1989 2.5 وقد
يتجاوز 5 إلى 7 مستقبلاً والجدول /16/ يبين استثمار الاراضي والمياه في المشرق العربي.
7 ـ بناء استراتيجية مائية لحوض دمشق مثالاً:
قبل استخدام الآلة لحفر الآبار وضخ المياه الجوفية وقبل الانفجار السكاني
والصناعي الطارئ ومنذ آلاف السنين فقد ساد في حوض دمشق توازن مائي تقليدي هو
بمثابة منظومة مائية بيئية تعكس حضارة الاجداد. كانت الينابيع المنتشرة في سهل
سرغايا والزبداني والديماس وصيدنايا وسفوح جبل الشيخ تمد التجمعات السكانية
باحتياجاتها من مياه الشرب والري الزراعي وكانت الفجارات الجماعية (وتدعى بالأقنية
الرومانية) تمد التجمعات السكانية في سهل القطيفة جيرود (ويظن أن الدولة السومرية
قد انشئت هذه الفجارات لجنودها على حدود الدولة لتامين المياه والغذاء لهم) (5)
كما اقيمت السدود التحويلية على وادي بردى والاعوج ووادي منين ـ التل لتمد
التجمعات على شريطي النهر. فقبل دخول بردى لدمشق انشئت ستة سدود تحويلية ليتفرع عن
بردى انهاراً هي: يزيد ـ تورة ـ بانياس ـ القنوات ـ الديراني ـ المزاوي وكانت
القنوات للشرب وبانياس للصرف الصحي بدمشق القديمة وبعد خروج هذه الانهار من دمشق
فانها تروي عشرين ألف هكتار اضافة لشبكة صرف الغوطة كأقنية شبعا والغزلانية (أي
اعادة استعمال المياه الجوفية للمرة الثانية للري) (13 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 17).
7 ـ 1 ـ المـوضـوع : يقع حوض دمشق في جنوب غرب الجمهورية العربية السورية
ويشغل مساحة قدرها 6850كم2 (الصفدي) أو 8630 كم2 (جايكا 1997) أو 8596 كم2 ( حوض
بردى والأعوج الذي يشترك في كثير من مساحته مع حوض دمشق) . ويقسم إلى قسم من
التضاريس (حوض بردى والأعوج) ولقسم منبسط حيث تقع الغوطة في غربه ووسطه والمرج في
شرقه وكثيراً ما ترد تسمية حوض دمشق مطلقة وتعني هذا السهل.. وما يصب على السهل من
الأحواض الصبابة المحيطة وأشهرها حوض بردى والأعوج .
يعد نهر بردى من منبعه (والنبع هو تدفق للمياه الجوفية)، الشريان المائي
الأهم في الحوض، وتبلغ مساحة حوضه الصباب حوالي 1380كم2 ويبلغ متوسط تصريفه السنوي
3.1 م3/ثا ، ومع إهمال التصاريف الشهرية التي تبين أن الحوض الصباب مغذياً لنهر
بردى بمياه سطحية في فصل الشتاء تقريباً بينما النبع (مياه جوفية ) من جبال لبنان الشرقية
(سفوح جبال الشير منصور) يتدفق باستمرار على مدار السنة . يرفد نهر بردى مجموعة من
الينابيع والوديان أهمها جريان وادي القرن ونبع عين الفيجة الذي يعتبر أكبر
الينابيع في حوض دمشق (والذي يتغذى من حوض القلمون حتى حسية) ويبلغ متوسط تصريفه
السنوي 7.71م3/ثا ويستثمر من مياهه سنوياً 4.6م3/ثا لتغذية مياه شرب دمشق (وتتصف
مياهه بنوعية عالية الجودة) ، وعندما يصل نهر بردى للسهل المنبسط فقد كان تصريفه
14م3/ثا ليستخدم لأغراض الري وتغذية المياه الجوفية التي تغذي آبار مياه الشرب في
الغوطة الشرقية وآبار مياه الري أيضاً. لذلك لايصل من بردى إلى بحيرة العتبة إلا
القليل وفي السنوات الخيرة بالأمطار .
يتشكل نهر الأعوج على سفوح جبل الشيخ نتيجة لاتحاد فرعيه السيبراني
والجناني حيث تبلغ مساحة الحوض الصباب لنهر السيبراني 130كم2 ولنهر الجناني 124كم2
وهما مسيلان موسميان عند ذوبان الثلوج وترفد السيبراني ينابيع عين عيسى وعين
المالحة وعين سابا والرشاشيح وغيرها بتصريف وسطي حوالي 0.6 م3/ثا (فيصبح السيبراني
دائم الجريان نتيجة للينابيع من مياه جوفية) وترفد الجناني نبع بيت جن بتصريف وسطي
0.84 م3/ثا ونبع المنبج 0.78 م3/ثا ونبع الطماسيات 0.78م3/ثا حيث يذهب جزءاً من
جريان النهر 0.5 م3/ثا إلى حوض الخنافس في الجنوب وبالتالي فالحوض الصباب حوالي
1120كم2 ويرفده إلى الأسفل من منطقة أم الشراطيط مياه نبع الطبيبية بتصريف وسطي
قدره 0.83 م3/ثا ليصح تصريف نهر الأعوج 4.7 م3/ثا (في الظروف الطبيعية) وحالياً بتصريف
وسطي 2.2م3/ثا؟
ولا تصل المياه إلى بحيرة الهيجانة إلا في السنوات غزيرة الأمطار . وموسم
الفيضان لبردى والأعوج يبد من شهر كانون الأول ويستمر حتى شهر أيار أحياناً ومع
تغير المناخ العالمي فقد يتأخر موسم الفيضان . وموسم التحاريق يبدء بشهر حزيران
ويستمر حتى شهر تشرين الثاني .
يرتبط نظام جريان بردى بعوامل منها : نظام التشغيل لسد التكية والسحب المائي من
نبع بردى ونبع الفيجة وصرف المياه المستعملة لمدينة دمشق والسحب المائي لتزويد
المياه في مناطق الاصطياف وتوسع مدينة دمشق والسحب المائي لري مزارع جديدة خارج
أراضي غوطة دمشق التقليدية ، كما يتأثر جريان الأعوج بأكثر العوامل المؤثرة على
جريان نهر بردى . وتلعب التغذية الجوفية لنهر بردى وسطياً بمقدار 94-97% ولنهر
الأعوج وسطياً بمقدار 77-82% .
المتوسط السنوي للهطول المطري لحوض (بردى والأعوج) حوالي 2659 مليون م3/
السنة وتبلغ قيمة التبخر 1808.8 مليون م3/السنة وبالتالي فمتوسط الموارد المائية
السنوية للحوض 850 مليون م3/السنة وفي دراسات جايكا قدر المتوسط للموارد المائية
بـ650م م3/ السنة حيث تشكل موارد سلسلة جبال لبنان الشرقية 77% من الموارد المائية
العامة في الحوض تقريباً. وعموماً فكميات المياه الممكن استثمارها من أصل الموارد
العامة في الحوض لاتتجاوز 65-70% أي ما يعادل 550-595 م م3/السنة في أحسن الحالات
وهي موارد مائية تقليدية (موارد مائية جوفية متجددة) وهناك الاحتياط الطبيعي أو
(المياه غير المتجددة في حوض دمشق) والتي يتم اللجوء إلى استثمارها في سنوات الشح
كما حصل عام 1999 وذلك أن الموارد المائية الطبيعية غير كافية لتغطية الطلب فحوض
الزبداني مثلاً هو حوض فرعي في الحوض ويدعوه أحياناً بالمنطقة الجبلية في الحوض A-
I .1, 2 , 3 , 6 بمساحة 1265 كم2 وبفرض أن الهبوط الممكن والمسموح به لمناسيب
المياه بحدود 100م وقيمة المعطائية المائية 0.02 فإن حجم الاحتياطي الساكن يساوي
1265×0,1 × 0,02 = 2530 م م3/ والتي يمكن استنزافها خلال 3 أو 4 سنوات شحيحة وهذا
يعني خللاً بالموازنة المائية لاتعوض؟ كما أن حساب الاحتياطي الطبيعي لمخزون
المياه الجوفية في غوطة دمشق قد أعطى 1426,1م م3 وهو مايكفي لسنتين متتاليتين من
الشح ومع المصادر الجبلية التي يمكن استجرارها خلال سنوات قليلة نكون قد وصلنا إلى
كارثة محققة ؟ كما أن الاحتياطي الطبيعي في توضعات الجوراسي والكريتاسي حوالي
545.5 م م3 وهي صعبة الاستثمار ومكلفة ؟ إذاً فما هي الاحتياجات المائية
المستقبلية والراهنة لمحافظة ريف دمشق ومحافظة دمشق لأغراض الشرب أو الاستعمالات
المنزلية والبلدية؟ حيث يبلغ انتاج الآبار العاملة لإمدادات بلديات ريف دمشق بحدود
72م م3 سنوياً منها 29 م م3 من الآبار المحفورة على توضعات الرباعي حوالي دمشق
(الشرق والجنوب والجنوب الغربي) و 10م م3 من الآبار المحفوة على توضعات النيوجين
والباليوجين في منطقة القطيفة وجنوب دمشق كالدير علي وشرق دمشق كالغزلانية و 30 م
م3 للآبار المحفورة على توضعات الكريتاسي على السلاسل الجبلية من ضاحية الأسد
بحرستا إلى جبل أبو العطا وسفح الجبل الشمالي لقرية المضمية (في حويضة جيرود)
وسلسلة جبال لبنان الشرقية لتغذية قرى منطقة النبك بينما النبك ودير عطية لها
مصادر أخرى من سلسلة جبال بين منطقتي القلمون (النبك والقطيفة) ، والبقية من
ينابيع بمقدار 1م م3 سنوياً وآبار الجوراسي العميقة.. ومجموع الآبار 770 بئراً ،
علماً أنهم بحاجة إلى 300م م3 سنوياً كعجز حتى سنة 2030؟ وتقترح مؤسسة مياه ريف
دمشق تأمين المياه من حوض الساحل كحل مؤقت ثم جر مياه حوض الفرات حتى سنة 2040
وبعدها لابد من تحلية مياه البحر بعد عام 2040 (18) علماً أن نوعية المياه بريف
دمشق ذات قساوة 140مغ/ل لنبع بقين و 950 مغ/ل لبئر الضمير وفي مياه المطر 80مغ/ل
والمسموح به 500 مغ/ل أما الكبريتات فقيمتها 6مغ/ل لنبع عين الفيجة ، و 1430 مغ/ل
لمياه جديدة الخاص وفي مياه الأمطار 25مغ/ل والمسموح به 250مغ/ل وقيمة الأمونيا
صفر غالباً و 10مغ/ل لبئر بدير عطية وفي مياه الأمطار 3.5 مغ/ل والمسموح به 0.05
مغ/ل وأما الفلور في مياه شرب رنكوس 0.05 مع/ل وفي الضمير (بئر خاص) 2.3 مغ/ل وفي
مياه المطر 0.22 مغ/ل ومسموح حتى 1 مغ/ل وهناك مواصفات جرثومية تتحقق بكلورة
المياه (19).
أما الاحتياجات البلدية لمدينة دمشق وقرى وادي نهر بردى التي لها حق الشرب
من مياه نبع الفيجة والمخالفات حول مدينة دمشق فهي حوالي 900 ألف م3 يومياً
والانتاج الحالي عام 2000 أقل بـ 186600 م3 يومياً ، أي العجز الحالي 2.16م3/ثا
وسيصل هذا العجر إلى 31م3/ثا سنة 2040 علماً أن الانتاج الحالي 35م م3 سنوياً من
الآبار و 160 م م3 سنوياً من نبع عين الفيجة و 35 م م3 سنوياً من نبع بردى وتقترح
مؤسسة مياه دمشق أيضاً جر مياه حوض الساحل ثم جر مياه من حوض الفرات (20) أي
الحاجة لمليار م3 سنوياً (1كم3) في سنة 2040 ويظن بعض الخبراء أن الحاجة أكثر من
ذلك اعتباراً من سنة 2000 وحتى سنة 2040؟ .
7 ـ 2 ـ التنمية المستديمة لحوض دمشق : تشكل مياه الصرف الصحي لمدينة دمشق
وريفها أحد العناصر الهامة للموارد غير التقليدية في حوض دمشق، والتي تستخدم للري.
والتي تقدر بحوالي 350م م3 سنوياً (عام 1998) ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم حتى سنة
2010 علماً أن استعمالات المياه البلدية يسبب فواقد تقدر بـ 10-20% كفواقد في
شبكات الصرف الصحي بالتبخر والتسرب .
وتشكل المياه الراشحة من المساحات المروية المصدر الثاني للموارد المائية
المستديمة حيث تبلغ المساحات المروية في حوض بردى والأعوج حوالي 66000 هكتار
يستخدم في ريها 982.8 م م3 في السنة منها 430 م م3 من المياه الجوفية و 552.8 م م3
من المياه السطحية ؟ (21) . ولما كانت المياه الراشحة 42% من المياه المستخدمة
للري وتغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في غوطة دمشق أي 982.8 × 42/100 =
412.78م م3 وهي قريبة من كمية المياه الجوفية التي استعملت للري 430م م3 + المياه
البلدية لريف دمشق 72 م م3 + المياه البلدية لدمشق 35 م م3 . ولكن الفرق هو
استنزاف للمياه الجوفية وتسبب خللاً بالموازنة المائية - البيئية ، لحوض دمشق ؟
وباستعمال المياه الجوفية مرة أخرى للري والتوسع به فإن نسبة المياه العائدة إلى
الطبقة الجوفية 42% والباقي يضيع بالتبخر والانفضاج واستعمالات النباتات ولدى
الجهات المعينة خرائط لمناسيب المياه الجوفية وتغيرها نتيجة لازدياد السحب المائي
والصفات الرشحية غير الجيدة نسبياً للصخور وعدم توفر مصادر تغذية كافية لهذه
المناطق مما تسبب في استنزاف الاحتياطي الطبيعي لحوض دمشق (21) . وترى مديرية بردى
والأعوج (21) أن محدودية الموارد المائية في حوض بردى والأعوج تستوجب اتخاذ بعض
الاجراءات الكفيلة بتخفيض الهدر واستخدام تقنيات جديدة في الري وترميم شبكات امداد
المياه البلدية لتخفيف الفاقد وترميم أقنية الري وإكسائها ودراسة إمكانية إيجاد
مصدر رديف وآمن من خارج حوض بردى والأعوج لتأمين الاحتياجات المائية اللازمة على
المدى المنظور !! لكن لمديرية الري واستعمالات المياه بوزارة الزراعة آراء أخرى(7)
لأن إجمالي المساحة المروية بمحافظة ريف دمشق 73180 هكتار ، يستجر لها من مصادر
مائية (أنهار - ينابيع - 3962 بئر مرخص و 26072 بئر غير مرخص) 1340.4 م م3/ السنة
. ويقدر البعض أن 1400-1500 م م3 بالسنة هي موارد مستعملة فعلاً بينما المتوسط
السنوي للموارد المائية 850م م3 / السنة .
وبالتالي يبلغ العجز 490.4 م م3 / السنة !! وتقدر هذه الاحتياجات المائية
السنوية للزراعة (بدون الاستعمالات البلدية) بـ 1340.4 م م3/ السنة بكفاءة استخدام
45-50% ويقدر أن المياه العائدة لتغذية المياه الجوفية بحوالي 335.1 م م3/ السنة
ويعاد ضخها واستخدامها . أي أن الاحتياجات المائية السنوية الصافية للزراعة
1340,4-335,1 = 1005,3 م م3/ السنة وذلك يفوق المصدر المائي السنوي القابل
للاستثمار والمقدر بـ 850م م3/ السنة (ما عدا الاستخدامات البلدية والصناعية).
إذاً فالعجز المائي 1005.3 - 850 = 155.3 م م3/ السنة . وتقترح الجهات
المعنية أن لانستعمل المياه الجوفية مرة أخرى للري وإنما يغطي هذا العجز بإقامة
شبكة ري تعتمد على الاستثمار المشترك للمياه الجوفية (وبذلك يخف الهدر الحاصل في
الآبار غير المرخصة مثلاً ..) والاقتراح الثاني للجهات المعنية مبني على تجارب
مخبرية على أصناف النبات وأنواع التربة ولمناطق مناخية مختلفة ويعتمد على :
استخدام شبكات الري المضغوطة لتمكين الفلاحين من استخدام الري بالتنقيط والرذاذ
للمحافظة على المساحات المروية الحالية ؟
إذاً لابد من مسح مصادر المياه السطحية والجوفية لحوض دمشق بهدف التنمية
المستديمة وإعادة ترتيب الأولويات بحيث تعطي الأفضلية الأولى لقطاع الاستعمالات
البلدية (الشرب) فالتنمية المستديمة تعني تحقيق موازنة مائية بيئية دائمة فإذا
كانت المصادر المائية المتاحة وسطياً 850م م3/السنة فذلك يعني أن لايزيد عدد
السكان بدمشق وريفها عن 7.5مليون نسمة حتى تتوازن المصادر المائية مع الاستعمالات
البلدية فقط ويظن بعض المتشائمين أننا قد تجاوزنا ذلك قبل سنة 2000 . إذاً لابد من
توفير مصادر مائية جديدة أو إغراء السكان بحوض دمشق بالهجرة إلى مكان تتوفر فيه
المياه كالجزيرة السورية مثلاً ، (باتجاه الفرات ودجلة ضمن خطط التنمية المستديمة
المستقبلية) . إذاً إما أن ننقل المياه من حوض الفرات مثلاً لدمشق، أو ننقل السكان
من دمشق إلى حوض الفرات (أيهما الأكثر اقتصاداً) وأن توفر المزيد من المياه
فالأفضلية الثانية لقطاع الصناعة لأن العائد المادي لاستعمال المياه بالصناعة
يعادل 30 ضعفاً عن العائد من استعمال المياه للري. وأن تعطي الأفضلية الثالثة
للسياحة والاصطياف، ثم تعطي الأفضلية الرابعة للري والحصول على الأمن الغذائي
النسبي، ثم تعطى الأفضلية الخامسة للتشجير وتربية الأحياء المائية في المياه التي
لاتصلح للري .. .
7 ـ 3 ـ المصادر المائية الجديدة للتنمية المستديمة لحوض دمشق :
7 ـ 3 ـ 1 ـ جر المياه السورية من الجولان : وهذا لايتحقق إلا بكسر الهيمنة
الصهيونية على المنطقة واسترداد حقنا بمياه الجولان تبعاً للقوانين الدولية
والسلام المنوي إقامته هو تنفيذ للشرعية الدولية وبالتالي يمكن أن نتذكر أواخر 1952
حيث تعاقدت وكالة إغاثة اللاجئين مع مؤسسات مالية عالمية للحصول على الاعتمادات
الكافية لتحقيق مشروع استعمال مياه نهر الأردن واليرموك من أجل ري سهول وداي
الأردن وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها. وقد تقرر حينئذ أن تدرس جميع الحلول
التي وردت من مؤسسات فنية مختلفة من أجل معرفة قيمة المشروع الذي تريد تمويله
وكالة اللاجئين ، من حيث توافقه مع الفن والاقتصاد وقبل الموافقة على مشروع وكالة
إغاثة اللاجئين، قرر مدير الوكالة ومستشاروه تكليف إدارة مدينة تنسي فالي في
الولايات المتحدة الأمريكية إبداء رأيها في الموضوع (وكانت هذه الإدارة تدرس
برنامج أيزنهاور لحوض المسيسيبي وتحظى باحترامه) وتقرر أن يكون عمل هذه المؤسسة
مجرداً عن الحدود السياسية ولا يأخذ بعين الاعتبار إلا الأسباب الفنية البحتة (22)
وقد وضعت المؤسسة المذكورة مشروعاً سمي باسم "جونستون" نسبة إلى مبعوث الرئيس
الأمريكي أيزنهاور "إيرك جونستون" ، وقد بني مشروع جونستون على الوثائق
التي قدمتها وكالة إغاثة اللاجئين ، ولم يقم واضعوه بزيارة الأراضي التي سينفذ
فيها، كما أنهم لم يتصلوا بالدوائر المختصة في الدول التي لها مصالح في المشروع .
ومن هذه الوثائق مشاريع إسرائيلية كمشروع استصلاح الحولة، ومشروع أقنية اليرموك
ومشروع بعثة كلاب أو مشاريع الإنماء الموحد ومشاريع جزئية أخرى ومشروع وادي الأردن
(مشروع لودرميلك) ومشروع هايز وسافيج.. ومصادر بريطانية كتقرير أيونيدس وماكدونالد
ومصدر من الأمم المتحدة (تقرير بعثة الشرق الأوسط (بونجر) عن خزان المقارن) .
ويشمل المشروع ناحية الري وناحية توليد الكهرباء ويقوم مشروع الري على
إنشاء ثلاث قنوات رئيسية: القناة الأولى وتجمع مياه الينابيع المنحدرة من أنهر
كالحاصباني في لبنان وبانياس ومياه حوض الحولة طبريا في سوريا والدان في فلسطين
وتسير هذه القناة إلى قناة الجليل المرتفعة لإرواء مناطق وادي فجة والعفولة وبيسان
ويبلغ طول هذه القتاة 120كم وبتصريف 14م3/ثا أو حوالي 450 م م3 سنوياً وكانت
النتائج المنتظرة من مشروع الثلاثة أقنية في ما يتعلق بالري هو الاعتراف لسوريا بـ
45 م م3 سنوياً (22) ورفضت اسرائيل هذا المشروع لاستثمار موارد المياه في أيار
1954 وقدمت بدلاً عنه مشروعها المسمى بمشروع قطن Coton حيث أدخلت فائض نهر
الليطاني اللبناني فأصبحت الموارد المائية 2345 م م3 تأخذ اسرائيل منها بحسب
مشروعها 1290 م م3 سنوياً وقدم العرب مشروعاً عربياً يختلف عن المشروع الأمريكي
والمشروع الإسرائيلي. ورأت اللجنة الفنية العربية أن يكون استغلال مياه نهر الأردن
وروافده شمال بحيرة طبريا بحيث يتضمن:
أ- ري المساحات الآتية الصالحة للزراعة في أحواض هذه الأنهار في لبنان
وسوريا وفلسطين :
أ . 1 - تحتاج أراضي حوض الحاصباني في لبنان بمساحة 3500 هكتار إلى 35 م م3
سنوياً مع أن مشروع جونستون قد أسقط من حسابه ري أية أراضي في حوض نهر الحاصباني
مع أن هذا النهر ينبع ويمر في أراضي لبنانية .
أ . 2 - تحتاج الأراضي بحوض
نهر بانياس إلى 20 م م3 سنوياً لري 3000 هكتار وتحتاج أراضي البطيحة لـ 22م م3
سنوياً لري 2200 هكتار على أن مشروع جونستون وقد أسقط من حسابه ري أراضي حوض نهر
بانياس مثلاً أي أن المشروع العربي قد أعطى 42 م م3 لري أراضي سورية شمال طبريا
و90 م م3 سنوياً لسهول أعالي اليرموك وحوض اليرموك بين سد المقارن وسد العدسية وقد
أقر مشروع جونستون بصيغته النهائية، حصة سوريا بـ 132 م م3 سنوياً وحصة لبنان بـ
35 م م3 سنوياً لكن اسرائيل كانت قد باشرت بمشروع ناقل المياه القومي سنة 1951
والذي انتهى سنة 1964 وكان من أسباب حرب 1967 حيث نقلت أغلب المياه المخزونة
ببحيرة طبريا بعيداً إلى صحراء النقب ويمكن تقدير مجموع ما تسرقه اسرائيل من
الجولان بـ 500-600م م3 سنوياً (24).
والآن إذا جرت المياه من حصتنا حسب القوانين الدولية من حوض بانياس
والبطيحة إلى دمشق بقيمة تتزايد سنوياً مع زيادة الاحتياجات بحوض دمشق حتى 500م م3
(علماً أن واردات المياه في الجولان 1.2 مليار م3 سنوياً) وبكلفة مقبولة لأن جر
المياه من منسوب 914 إلى 700 فوق سطح البحر بدمشق هي من أرخص المصادر المتوفرة
خارج حوض دمشق وأقربها حيث المسافة بحدود 80كم وهذه الكلفة ضمن إمكانيات سوريا
الاقتصادية والفنية وبأقل مدة للدراسة والتنفيذ !
تتلخص دراسات المرحوم المهندس صبحي كحالة حول هذا الموضوع وقد كان وزيراً
للري بسوريا بأن اسرائيل تحتقر حقوق الآخرين وتسرق مياههم وتجبرهم على الهجرة
ودراسات الاستشعار عن بعد التي تمت في سوريا لمياه الجولان ومع ماكتب عن مشاريع
اسرائيل وانفاق استجرار المياه الجوفية من الجولان فمحور الدراسة الحالية حوض مياه
دمشق وموازنته المائية والبيئية .
فالجولان وماعرف عن رطوبة هواءه مع جبل الشيخ من أفضل المواقع لقطف رطوبة
الهواء (5) إضافة للمياه المنقولة لحوض دمشق وبالتالي فقطف رطوبة الهواء ذات أثر
يمكن إهماله على البيئة والمياه المقطوفة تتجدد باستمرار وتحتوي 2/3 حمولة المياه
الصحية من المعادن الثقيلة ولاتحتوي على جراثيم وذات تهوية جيدة ولا تستهلك طاقة
وبكلفة (5ل.س) للم3 أي أنها أرخص من نصف كلفة التحلية بالأزموزية العكسية الحديثة
..
وأظن أن نجاح قطف رطوبة الهواء في الجولان وجبل الشيخ سيشجع الحكومة السورية
على التوسع من الغرب إلى شرق دمشق وتصل بالتوسع العمراني إلى البادية التي يجب أن
تزدهر كما كانت حسب مذكرات سنوحي (23) .
7 ـ 3 ـ 2 ـ جر المياه من الساحل السوري : يقدر الرصيد المائي لحوض الساحل
بدرجة تنظيم 65% بحوالي 1494 م م3 سنوياً ويمكن استجرار مياه تقدر بـ 906 م م3
سنوياً من المياه السطحية والمياه الجوفية لحوض الساحل ولكن كيف ستجمع هذه المياه.
وإذا جمعت وبغض النظر عن الكلفة العالية فإنها ستنقل من اللاذقية طرطوس إلى دمشق
عبر قمة تلكلخ بناقل قطره حوالي 3م وسرعة قريبة من 5م/ثا وسطياً ولمسافة تتراوح بين
400كم من اللاذقية إلى 270كم من طرطوس أي أن المسافة الوسطية أكثر من 300كم وبرفع
قد يكون من سطح البحر ذو المنسوب صفر إلى 700م منسوب دمشق فوق سطح البحر ومع فواقد
الاحتكاك فرفع المياه مكلف جداًوقد يفوق قدرة سوريا على تنفيذ مثل هذا المشروع وقد
تكون تحلية مياه البحر من طرطوس وضخ المياه المحلاة إلى سهول حمص وحسية طريقة لدعم
النفق الجوفي المغذي لنبع عين الفيجة ومضاعفة تصريفه هو الحل البديل .. وقد يكون
الأكثر ملائمة للبيئة لآن ري سهول حمص وحسية والقلمون بمياه البحر في المستقبل من
الطرق القابلة للنقاش خاصة وأن الوصول من حمص باتجاه تدمر والبادية لاستصلاحها
بمياه محلاة قد لاتكون طريقة مكلفة مع التقدم العلمي لتوليد الطاقة النووية ومع
تقدم صناعة الأغشية لطريقة الأزموزية العكسية ..
7 ـ 3 ـ 3 ـ جر المياه من الفرات إلى حوض دمشق (17) : نتيجة لدراسة خبراء
البنك الدولي سنة 1965، فقد كانت المساحات والمقننات المائية اللازمة لها على نهر
الفرات الأعلى في تركيا والأوسط في سوريا والأدنى في العراق كما يلي :
مجموع كمية مياه الري بالكم3 : 13.64 لتركيا ، و 7.59 لسوريا و 18.9 للعراق
والمجموع 40,13 كم3 .
ولكن نتيجة فحص ودراسة المناطق القابلة للري اقتصادياً في سوريا (في حوض
البليخ والفرات والرصافة وسهل الميادين) فقد وجد أنه من أصل 1310.000 هكتار يمكن
ري واستثمار 640000 هكتار وهذا يؤدي مستقبلاً إلى رفع الاحتياجات المائية في سوريا
لـ 16.742كم3 وفي العراق وبنفس الطريقة فقد رفعت الاحتياجات المائية إلى 25كم3
وعليه يكون :
مجموع كمية مياه الري بالكم3 : 13,64كم3 لتركيا و 16.742كم3 لسوريا و 25
للعراق والمجموع 55.382كم3 .
واستناداً لاقتراح الجانب العراقي إلى الجانب التركي في حزيران 1990 على
هامش الاجتماع الثاني لوزراء الري الثلاثة في أنقرة حول قسمة مياه نهر الفرات
مثالثة أي الثلث لتركيا والثلثين لسورية والعراق ، ولم يعقب عليه الجانب التركي في
حينه ، أي أنه لم يرفضه من حيث المبدأ. ومع المحافظة على الاتفاق السوري - العراقي
لعام 1989 (58% للعراق و 42% لسوريا من المياه المحررة على الحدود السورية - التركية
) وبذلك تكون حصة تركيا 10.47 كم3 أي 33% من إجمالي مياه النهر البالغة 31.4كم3
وسطياً (17) وبالنظر إلى المخطط التالي سترى أن كل الأطراف قد حصلت على حقوق تعيد
صلة الرحم والجوار لمعانيها السامية عبر التاريخ . حيث تنال تركيا ما تريده 13.64
وتنال سوريا 16.742 وتنال العراق 105كم3 بدلاً عن 25كم3.
وكذلك السعودية ودول الخليج العربي فبدلاً من ري المياه لشط العرب يمكن أن
يأخذوا مياهاً وعلى ضوء مثل هذه الاستراتيجية لمياه دجلة والفرات معاً يمكن اعطاء
حوض دمشق مليار م3 أي كم3 لأن المياه ستصل لري سهول حمص والسلمية وهي ليست ببعيدة
عن دمشق ولو افترضنا أننا سنضخ المياه من سد الطبقة فهي تعلو عن سطح البحر بـ 240م
ودمشق تعلو بـ 700م والضخ سيكون متعدد المراحل ليغطي فواقد الاحتكاك وفرق المنسوب
وبتذكر مشروع النقطة الرابعة لايزنهاور في منتصف القرن المنصرم سنجد أن ما يتوارد
كخواطر الآن ليس ببعيد عما أقترح بالأمس وأن الفرص الضائعة في الشرق الأوسط يمكن
أن تبعث من جديد وأن ما باليد حالياً هو قبض الريح وأن نهر التايمز في بريطانيا
العظمى بطول نهر بردى ويستعمل ستة عشر مرة (5) قبل أن يصب ما تبقى منه في البحر،
فلماذا لا نستخدم مياه دجلة والفرات معاً ولمرات متعددة ، إن التحكم بالنوعية أصبح
علماً متقدماً وقليل التكلفة (5) علماً أن المياه الراشحة من الري لا تقل عن 40%
وتصبح مياهاً جوفية قابلة للاستعمال مرة أخرى .
يشكر المؤلف وزارتي الري والزراعة والعاملين بصمت لبناء سوريا ويشكر جمعية
العلوم الاقتصادية السورية.
فهرس
الجداول